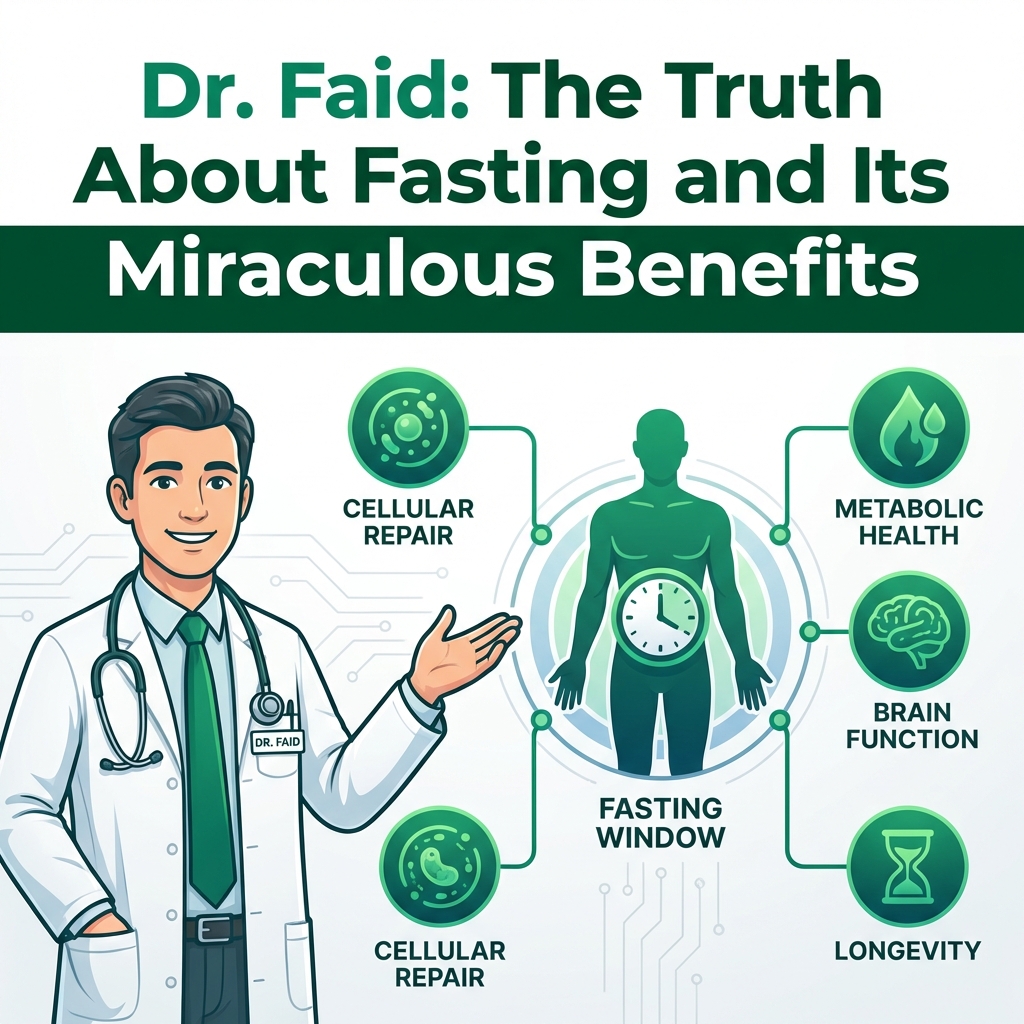ماذا لو كانت الظواهر التي نعتبرها خارقة للطبيعة، مثل التخاطر (التواصل العقلي عن بعد) والشفاء الذاتي، هي في الحقيقة قدرات كامنة في الإنسان تنتظر من يكتشفها؟ وماذا لو كانت النصوص القديمة والعلوم الحديثة، مثل فيزياء الكم، تلتقي عند نقطة واحدة لتؤكد أن للوعي الإنساني قوة تتجاوز حدود الجسد المادي؟ هذه الأسئلة الجريئة كانت محور رحلة استكشافية قامت بها متحدثة في مقطع فيديو حديث على يوتيوب، حيث توجهت إلى المكتبة الوطنية بالرباط للبحث عن إجابات في بطون كتب نادرة ومنسية، في محاولة لربط الحكمة القديمة بأحدث نظريات العلم.
في الفيديو، أوضحت المتحدثة أن دافعها كان الاستجابة لطلبات متابعيها الذين أرادوا التعمق في الموضوعات التي تطرحها، والتي تقع على تقاطع مجالات معرفية متنوعة مثل الباراسيكولوجي (علم النفس الخارق)، والإبستمولوجيا (فلسفة المعرفة التي تبحث في طبيعة وصحة معارفنا)، والميتافيزيقيا (علم ما وراء الطبيعة)، بالإضافة إلى فيزياء الكم وتطبيقاتها في الحياة اليومية. وأشارت إلى أعمال كتاب بارزين مثل فاديم زيلاند (صاحب نظرية ترانسيرفينج الواقع)، وجاكوبو غرينبرغ (العالم المكسيكي الذي درس الشامانية والوعي)، وديفيد بوم (الفيزيائي الذي طور نظرية النظام المتضمن)، كأمثلة على الفكر الذي يسعى لتوحيد العلم والروحانية.
جوهرة من الماضي: حكمة ابن زهر في اتصال النفس بالجسد
قبل الخوض في الكتب الحديثة، توقفت المتحدثة عند اكتشاف مهم في قسم المخطوطات، وهو مخطوط يعود للقرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) للطبيب الأندلسي الشهير أبو مروان عبد الملك بن زهر، المعروف في أوروبا باسم “Avenzoar”. المخطوط الذي يحمل عنوان “التيسير في المداواة والتدبير”، لم يكن مجرد كتاب في الطب التقليدي، بل كان يحمل في طياته رؤية متقدمة لعصره.
أوضحت المتحدثة أن ابن زهر، الذي وُلد في إشبيلية لعائلة عريقة في الطب، لم يكن جراحًا وعالم تشريح بارعًا فحسب، بل كان من أوائل من تحدثوا بوضوح عن تأثير الحالة النفسية على الصحة الجسدية. هذه الفكرة، التي تشكل اليوم حجر الزاوية في الطب النفسي الجسدي (Psychosomatic Medicine)، كانت رؤية ثاقبة في زمن كان يُنظر فيه إلى الجسد والروح ككيانين منفصلين. إن تأكيد ابن زهر على هذه الصلة يوضح أن فهم العلاقة بين العقل والجسد ليس اكتشافًا حديثًا، بل هو حكمة ضاربة في جذور التراث العلمي العربي والإسلامي.
استكشاف الظواهر الخارقة: هل هي علم أم خيال؟
انتقلت المتحدثة بعد ذلك إلى قسم الكتب الذي يتناول الظواهر الخارقة، أو ما يُعرف بالباراسيكولوجي، وهو مجال يثير جدلاً واسعًا بين الأوساط العلمية. استعرضت مجموعة من الكتب التي تحاول تقديم رؤية مختلفة لهذه الظواهر:
-
“إعادة الاعتبار للظواهر الخارقة” للدكتور جمال نصار حسين: يدعو هذا الكتاب إلى عدم رفض الظواهر مثل الشفاء الخارق (الشفاء دون تدخل طبي مادي)، التخاطر، واللمس العلاجي، لمجرد أن العلم السائد فشل في تفسيرها. يجادل المؤلف، وهو أستاذ فلسفة، بأن المنظومة المعرفية الحالية متحيزة ضد ما هو غير مألوف، ويدعو إلى تأسيس علم جديد يأخذ هذه الظواEار على محمل الجد.
-
“الظواهر الخارقة وأسرار الكون”: كتاب ضخم يجمع بين نشأة الكون ونظرية الانفجار العظيم وبين الظواهر الغامضة مثل العوالم الموازية والقارات المغمورة.
-
“خارقية الإنسان: الباراسيكولوجي من المنظور العلمي” للدكتور صلاح الجابري: يحاول هذا الكتاب التمييز بين الظواهر النفسية الخارقة الحقيقية وبين الممارسات غير العلمية كالسحر والشعوذة، ويقترح نظريات تفسيرية مثل “الوعي الكمومي” و”التزامن” لتفسير هذه الظواهر في إطار علمي.
ما هو رأي العلم الحديث؟
عند البحث عن أدلة علمية تدعم هذه الظواهر، نجد أن المجال محاط بالشكوك والتحديات المنهجية. على سبيل المثال، في مجال التخاطر، أُجريت آلاف التجارب على مدى عقود. مراجعة تحليلية (meta-analysis) نشرت في مجلة “PLOS ONE” عام 2018 فحصت تجارب “Ganzfeld” (وهي تجارب حسية معزولة لاختبار الإدراك خارج الحواس)، ووجدت تأثيرًا إحصائيًا صغيرًا ولكنه ذو دلالة، مما يشير إلى أن الظاهرة قد تكون حقيقية، لكن الباحثين أنفسهم دعوا إلى مزيد من الأبحاث المكررة والمصممة بدقة.
من ناحية أخرى، يرى علماء بارزون مثل مايكل شيرمر من “جمعية المتشككين” (The Skeptics Society) أن هذه النتائج غالبًا ما تكون نتاج صدفة إحصائية، أو عيوب في تصميم التجارب، أو حتى رغبة الباحثين في إيجاد نتيجة إيجابية. ومع ذلك، يستمر باحثون مثل دين رادين، كبير العلماء في “معهد العلوم العقلية” (Institute of Noetic Sciences)، في نشر دراسات تشير إلى وجود أدلة على أن الوعي يمكن أن يؤثر على العالم المادي، وإن كان ذلك بطرق دقيقة للغاية.
من المثير للاهتمام أن العديد من التقاليد الروحانية القديمة، مثل الأيورفيدا الهندية والطب الصيني التقليدي، تتحدث عن مفاهيم تشبه الطاقة الحيوية، مثل “برانا” (Prana) و“تشي” (Qi)، والتي يُعتقد أنها تتدفق في الجسم ويمكن توجيهها لتحقيق الشفاء، وهو ما يتقاطع مع فكرة “اللمس العلاجي” التي ذكرتها الكتب.
من الروحانيات إلى فيزياء الكم: جسر بين عالمين
لم تقتصر رحلة المتحدثة على الظواهر الخارقة، بل شملت كتبًا في الروحانيات والفلك القديم وعلم النفس، وصولًا إلى الفيزياء الحديثة:
-
“الخفايا” للدكتورة مريم نور: يدمج هذا الكتاب بين الفلسفة والروحانيات، ويتناول موضوعات الوعي والطاقة والروح، ويقدم نصائح عملية لتحسين جودة الحياة. الدكتورة مريم نور شخصية معروفة في العالم العربي بدعوتها لنظام الماكروبيوتيك الغذائي والعيش بانسجام مع الطبيعة.
-
“باب الأحلام” للدكتور علي كمال: يقدم هذا الكتاب تحليلاً نفسيًا علميًا للأحلام ودورها في الصحة النفسية، وهو مجال اهتم به عمالقة التحليل النفسي مثل سيغموند فرويد وكارل يونغ، واليوم يدرسه علم الأعصاب كجزء أساسي من عملية تنظيم الذاكرة والعواطف.
-
“الكتاب الكامل في أسرار النجوم” المنسوب لموسى بن نوبخت: يعكس هذا الكتاب الفلكي القديم اهتمام الحضارة الإسلامية بعلم التنجيم (Astrology)، الذي كان يعتبر آنذاك علمًا رفيعًا مرتبطًا بالفلك والرياضيات. ورغم أن العلم الحديث يصنف التنجيم كـعلم زائف (Pseudoscience) لعدم وجود أي دليل علمي يربط بين مواقع الكواكب وحياة الأفراد، إلا أن دراسة مثل هذه الكتب تمنحنا نظرة على تاريخ الفكر الإنساني.
نقطة الالتقاء: فيزياء الكم والشفاء الذاتي
في ختام جولتها، ربطت المتحدثة هذه الأفكار بعلمين حديثين بارزين:
-
آلان أسبكت (Alain Aspect): عالم الفيزياء الفرنسي الحائز على جائزة نوبل، والذي أثبتت تجاربه صحة ظاهرة التشابك الكمومي (Quantum Entanglement). تصف هذه الظاهرة كيف يمكن لجسيمين كموميين (مثل الإلكترونات) أن يظلا مترابطين بطريقة غامضة، بحيث أن قياس خاصية في أحدهما يؤثر بشكل فوري على الآخر، بغض النظر عن المسافة الفاصلة بينهما. أطلق أينشتاين على هذه الظاهرة اسم “التأثير الشبحي عن بعد”. يرى بعض المفكرين في هذا التشابك دليلاً على أن الكون مترابط في جوهره على مستوى عميق، ويستخدمونه كنموذج لشرح ظواهر مثل التخاطر والوعي الجمعي. ومع ذلك، يؤكد معظم علماء الفيزياء أن التشابك الكمومي ظاهرة تقتصر على العالم الميكروسكوبي، ولا يوجد دليل علمي حتى الآن على أنها تعمل على مستوى الأجسام الكبيرة أو تفسر الوعي البشري.
-
الدكتور جو ديسبنزا (Joe Dispenza): باحث وعالم أعصاب أصبح من أشهر الأصوات التي تدعو إلى إمكانية الشفاء الذاتي من خلال قوة العقل. يرتكز ديسبنزا على مفاهيم علمية مثبتة مثل اللدونة العصبية (Neuroplasticity)، وهي قدرة الدماغ على إعادة تشكيل نفسه وبناء مسارات عصبية جديدة بناءً على الأفكار والتجارب المتكررة، وعلم التخلق (Epigenetics)، الذي يوضح كيف يمكن للعوامل البيئية ونمط الحياة (بما في ذلك التوتر والمشاعر) أن تؤثر على طريقة عمل جيناتنا. تؤكد أبحاث علمية رصينة هذه المبادئ. على سبيل المثال، أظهرت دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) أن ممارسة التأمل بانتظام يمكن أن تغير بنية الدماغ ووظيفته، مما يعزز مناطق مرتبطة بالتركيز والتعاطف ويقلل من نشاط مناطق مرتبطة بالتوتر والقلق. كما أن تأثير الدواء الوهمي (Placebo Effect)، حيث يتحسن المريض لمجرد اعتقاده بأنه يتلقى علاجًا فعالاً، هو دليل قوي على قدرة العقل على التأثير في كيمياء الجسم. يتفق خبراء مثل بروس ليبتون، عالم بيولوجيا الخلية، مع ديسبنزا في أن معتقداتنا ومشاعرنا يمكن أن تغير بيولوجيتنا.
إن رحلة البحث عن المعرفة التي قامت بها المتحدثة تفتح الباب أمام حوار شيق بين الحكمة القديمة والعلم الحديث، وتدعونا إلى التفكير بعقل منفتح ونقدي في طبيعة الواقع وقدراتنا الكامنة.
تنويه: هذا المقال يلخص آراء خبراء ودراسات متاحة لأغراض تعليمية وتثقيفية فقط، ولا يعتبر استشارة طبية.