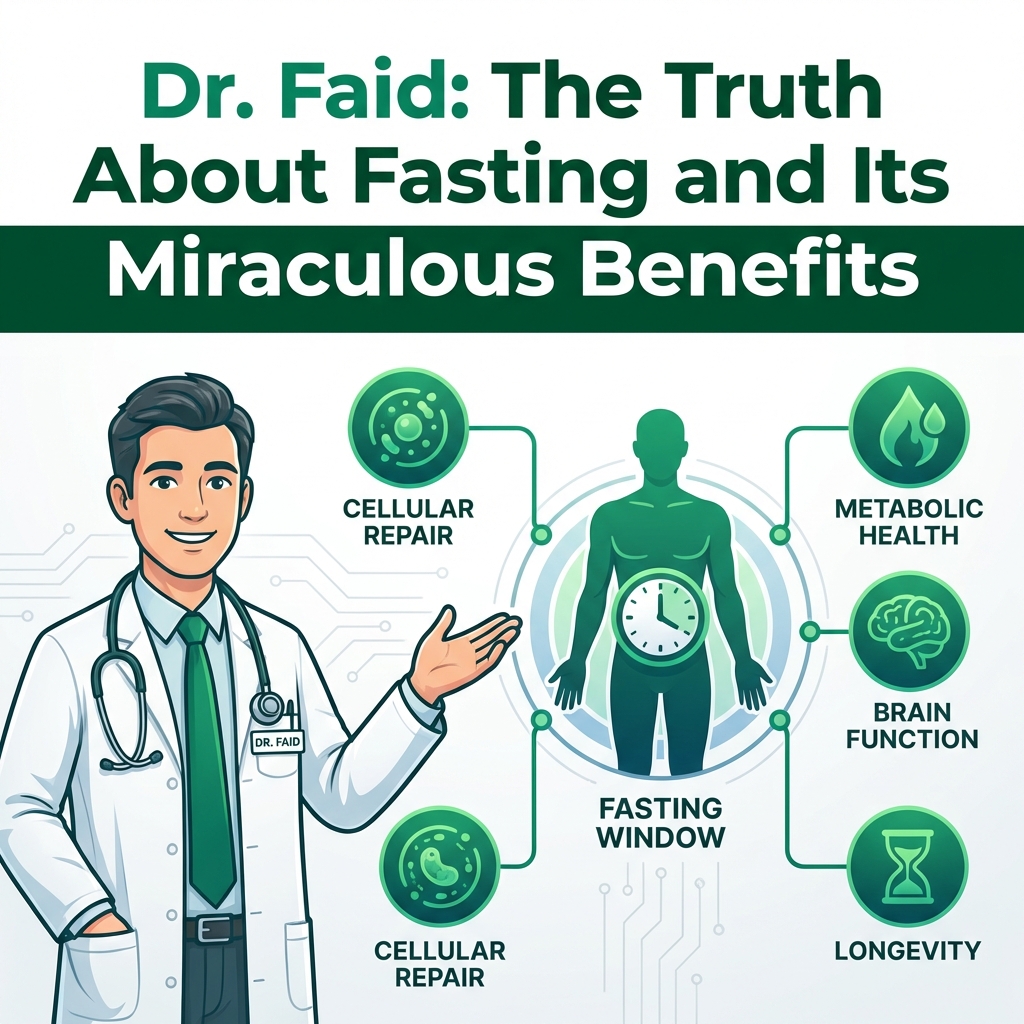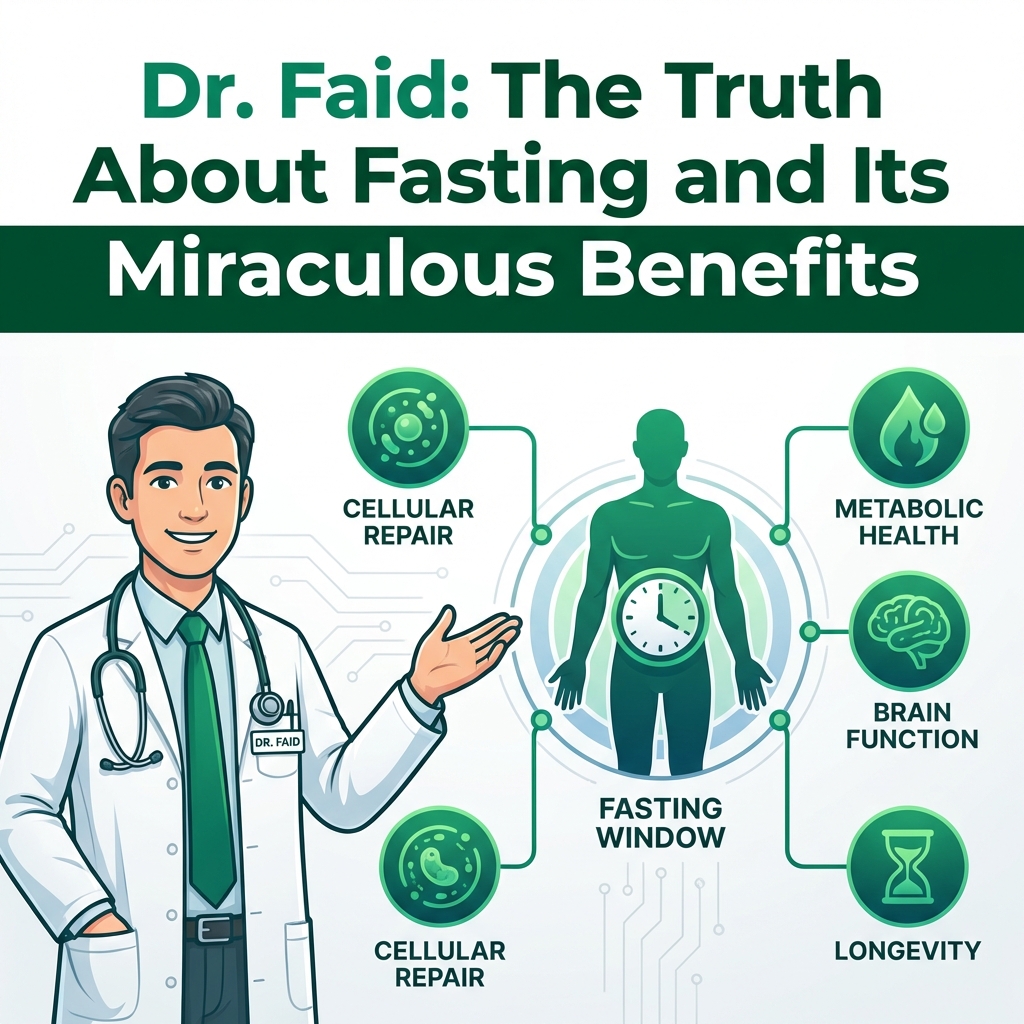ماذا لو كانت قصة بداية البشرية ليست قصة سقوط من الجنة وعقاب على خطيئة، بل قصة تكليف إلهي عظيم ومهمة كونية فريدة؟ في مقطع فيديو حديث على يوتيوب، قدم متحدث تحليلًا عميقًا ومختلفًا للآيات الأولى من قصة آدم في سورة البقرة، وهي قراءة قد تغير فهمنا التقليدي لدور الإنسان في هذا الوجود. يطرح المتحدث رؤية ترى في خلق الإنسان مشروعًا إلهيًا مقصودًا، يتمحور حول العقل والاختيار والقدرة على تجاوز الخير والشر، وهو ما يجعله مخلوقًا ذا إمكانات تفوق الملائكة أنفسهم.
السؤال الذي حير الملائكة والبشر
في حديثه، يروي المتحدث كيف استوقفته آيات محددة في سورة البقرة (الآيات 30-37)، مما دفعه إلى إعادة قراءتها مرارًا وتكرارًا. تبدأ القصة بإعلان إلهي مهيب: “وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً”. يشير المتحدث إلى أن مصطلح “خليفة” (أي من يخلف غيره أو يكون ممثلًا ووكيلًا) كان أول ما أثار دهشته. فالفكرة السائدة التي نشأ عليها، كما يذكر، هي أن وجود الإنسان على الأرض كان نتيجة عقاب على معصية آدم، لا تكريمًا وتعيينًا في منصب “الخلافة”. هذا التقديم الإيجابي لدور الإنسان كان بمثابة نقطة تحول في فهمه للقصة بأكملها.
لكن المفاجأة الأكبر كانت في رد الملائكة على هذا الإعلان الإلهي. لقد طرحوا سؤالًا يكشف عن قلق عميق ومنطقي: “قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ”.
يعلق المتحدث بأن هذا السؤال هو بالضبط سؤاله هو، وسؤال الكثيرين من البشر عبر العصور. إنه سؤال يلامس جوهر “مشكلة الشر” (The Problem of Evil) في الفلسفة واللاهوت: لماذا يخلق الله كائنًا لديه القدرة على ارتكاب هذا الكم الهائل من الفساد والعنف وسفك الدماء، بينما كان بإمكانه أن يكتفي بمخلوقات نورانية كالملائكة، لا يصدر منها إلا التسبيح والتقديس؟ يرى المتحدث أن هذا السؤال لخص كل صراعاته وشكوكه وتجاربه مع الجانب المظلم من الطبيعة البشرية. لقد كان سؤال الملائكة بمثابة مرآة عكست حيرته الوجودية.
الجواب الإلهي: سرّ المعرفة والعقل
يأتي الجواب الإلهي الأول موجزًا ولكنه يحمل في طياته ثقلًا هائلًا: “قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ”. للوهلة الأولى، قد يبدو هذا الجواب قاطعًا ومُنهيًا للنقاش، لكن المتحدث يكتشف أن القرآن لا يترك السؤال معلقًا، بل يبدأ في الإجابة عليه بطريقة عملية ومدهشة.
تأتي الآية التالية لتكشف عن أول جزء من هذا السر: “وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ”. هنا، ينتقل التركيز فورًا إلى العقل والمعرفة. الإنسان، ممثلًا في آدم، هو كائن متعلّم. الله هو معلمه الأول، وأول ما وهبه إياه هو القدرة على التسمية والترميز، أي “اللغة” وما تحمله من قدرة على التصنيف والفهم والتجريد. هذه الهبة، كما يوضح المتحدث، ليست مجرد قدرة على إطلاق مسميات، بل هي أساس الحضارة والفكر والعلوم.
عند البحث عن أدلة تدعم هذه الفكرة، نجد أن الفكر الإسلامي قد أولى “العقل” مكانة مركزية. فلاسفة كبار مثل ابن رشد والفارابي رأوا في العقل أسمى ما يملكه الإنسان، وهو الأداة التي تمكنه من فهم العالم والوصول إلى الحقيقة. وفي دراسة بعنوان “The Role of Intellect in Islamic Civilization” (دور العقل في الحضارة الإسلامية)، يؤكد الباحثون أن القرآن يحث في أكثر من 700 آية على التفكير والتدبر والنظر، مما يجعل السعي وراء المعرفة واجبًا دينيًا. وهذا يتوافق تمامًا مع ما لاحظه المتحدث من تكرار القرآن للدعوة إلى استخدام المدارك العقلية، كما في قوله تعالى: “اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ… الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ”. إن القلم، أداة العلم، هو من أعظم نعم الله على البشر.
عندما عُرض هذا الاختبار المعرفي على الملائكة، كان اعترافهم واضحًا وصريحًا: “قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ”. لقد أقروا بأن هذه المهمة الفكرية تتجاوز طبيعتهم وقدراتهم. علمهم وظيفي ومباشر، بينما يمتلك الإنسان قدرة كامنة على التعلم المستمر والابتكار المعرفي. ثم يأتي دور آدم ليُظهر هذه القدرة الفائقة بكل بساطة: “قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ…“. لقد نجح آدم في الاختبار بسهولة، مثبتًا أن لديه بُعدًا معرفيًا فريدًا.
ما كشفته الملائكة وما أخفته
بعد هذا العرض العملي لقدرات الإنسان، يعود القرآن إلى الحوار الأول، حيث يقول الله للملائكة: “قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ”. يتوقف المتحدث عند هذه العبارة الأخيرة: “ما تبدون وما كنتم تكتمون”.
ما الذي أبدته (كشفته) الملائكة؟ الجواب واضح: لقد أبدوا تخوفهم من قدرة الإنسان على الشر والفساد وسفك الدماء. وما الذي كتمته (أخفته أو لم تدركه) الملائكة؟ هنا يكمن عمق التحليل. يرى المتحدث أن ما لم تدركه الملائكة هو الوجه الآخر للعملة: قدرة الإنسان الهائلة على فعل الخير. إذا كان الإنسان قادرًا على ارتكاب أقصى الشر، فهو أيضًا قادر على بلوغ أسمى درجات الخير والرحمة والجمال والتضحية. إنه مخلوق ذو قطبين، يمتلك حرية الاختيار بينهما. الملائكة، في رؤيتهم، ركزوا على نصف الحقيقة فقط، النصف المظلم، بينما غابت عنهم الإمكانات المشرقة التي لا حدود لها.
هذه الفكرة تجد أصداءً في العديد من النظم الفكرية والروحية. في الطب الصيني التقليدي، يمثل مفهوما “الين واليانغ” (Yin and Yang) القوتين المتكاملتين والمتضادتين في الكون، حيث لا يمكن فهم الظلام إلا بوجود النور، ولا الشر إلا بوجود الخير. وكذلك في الفلسفة الإسلامية، يُنظر إلى “النفس” البشرية (The self or psyche) على أنها ساحة صراع بين نوازع الخير (الإلهام) ونوازع الشر (الوسوسة)، وهذا الصراع هو جوهر الاختبار البشري. يتفق مفكرون معاصرون مثل الدكتور مصطفى محمود في كتاباته على أن حرية الاختيار هذه هي سر تكريم الإنسان، فالاختيار هو ما يمنح للفعل الأخلاقي قيمته.
السجود لآدم: خدمة المشروع البشري
تصل القصة إلى ذروتها الدرامية بالأمر الإلهي: “وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ”. يحلل المتحدث هذا السجود بأنه لا يعني العبادة، بل يحمل معنيين رمزيين عميقين:
- الاعتراف بالتفوق الكامن: إنه إقرار من الملائكة بأن هذا المخلوق الجديد، بما أوتي من علم وحرية إرادة، يمتلك إمكانات قد تتجاوز إمكاناتهم.
- التسخير والخدمة: السجود يرمز أيضًا إلى أن القوى الكونية، بما فيها الملائكة، مسخرة لخدمة المشروع البشري على الأرض. ستكون هذه القوى، سواء كانت ملائكية (تمثل الخير والإلهام) أو شيطانية (تمثل الشر والوسوسة)، بمثابة محفزات للاختيار الأخلاقي للإنسان.
هذه النقطة الأخيرة بالغة الأهمية. يرى المتحدث أن وجود قوى الخير والشر ليس عبثيًا، بل هو جزء من تصميم إلهي متقن. هذه القوى تزيد من وعي الإنسان بقراراته، وتجعل اختياراته ذات معنى. في النهاية، القرار يعود إلى “النفس” البشرية، التي تخوض اختبارًا تلو الآخر، إما للارتقاء والنمو الروحي، أو للانحدار. وهذا الصراع المستمر هو محرك التطور الروحي للإنسان في رحلته للعودة إلى الله. وقد أشار إلى هذه الفكرة فلاسفة ومتصوفة كبار مثل ابن عربي الذي رأى في الوجود كله تجليات للأسماء الإلهية، بما فيها أسماء الجلال (التي قد تظهر في صورة الشر) وأسماء الجمال (التي تظهر في صورة الخير)، والإنسان هو المخلوق الذي يستطيع أن يكون مرآة لكل هذه الأسماء.
خلاصة ورؤية جديدة
يقدم هذا التحليل للقصة القرآنية رؤية متكاملة ومختلفة جذريًا عن الفهم التبسيطي للخلق. فبدلًا من قصة خطيئة وعقاب، نجد قصة تكليف وتكريم. الإنسان ليس مجرد مخلوق ساقط، بل هو “خليفة” الله في الأرض، كائن فريد زُوِّد بأدوات استثنائية هي العقل والمعرفة وحرية الإرادة. إن قدرته على الشر، التي أثارت قلق الملائكة، هي نفسها الوجه الآخر لقدرته على الخير، والاختيار بينهما هو جوهر وجوده ومهمته. وبهذا المعنى، فإن قصة آدم ليست مجرد حكاية من الماضي، بل هي قصة كل إنسان في كل زمان ومكان، في صراعه اليومي وارتقائه المستمر نحو تحقيق إمكاناته الكاملة.
تنبيه: هذا المقال يلخص آراء المتحدث والدراسات المتاحة لأغراض تعليمية وتثقيفية فقط، ولا يمثل نصيحة طبية أو دينية ملزمة.