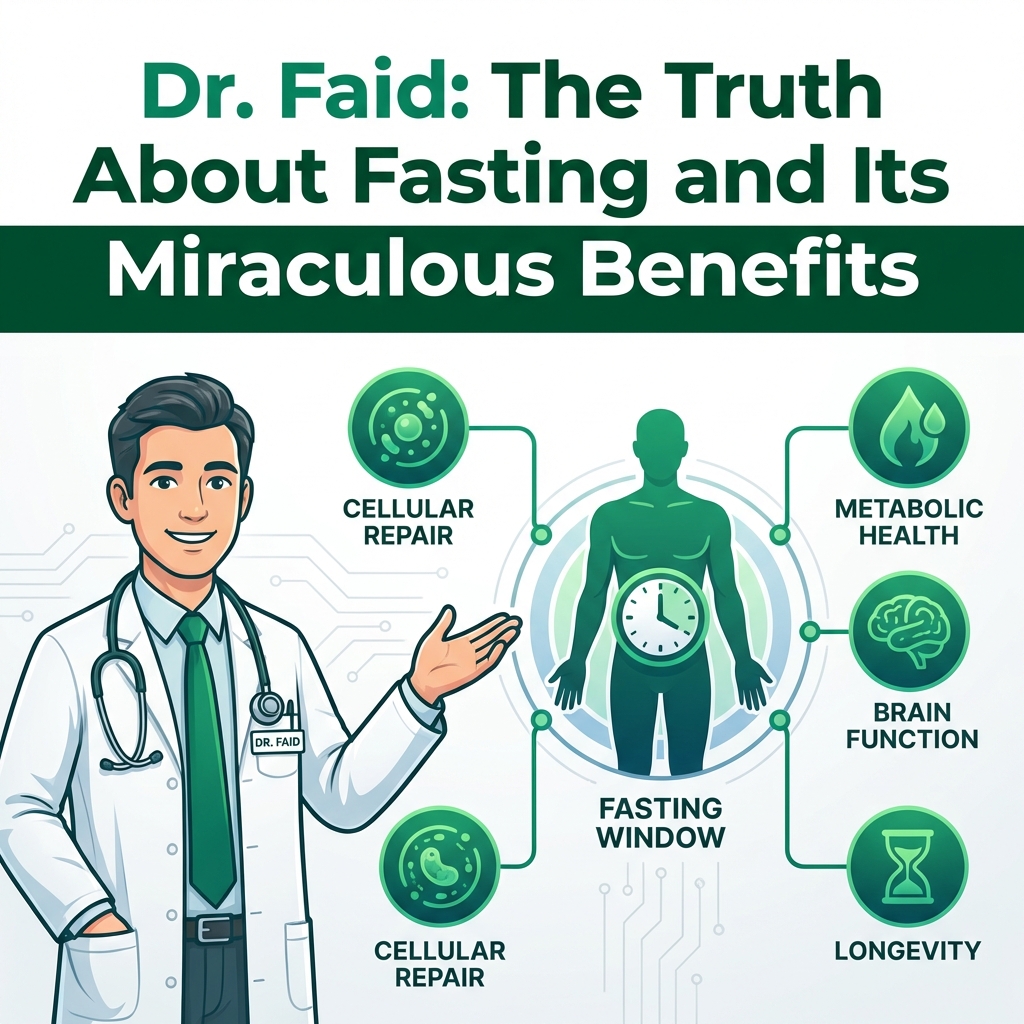هل يمكن أن يكون كل ما تعلمناه عن كيفية إبصارنا للعالم ليس الحقيقة الكاملة؟ ماذا لو كان الدماغ، هذا العضو المادي المعقد والمظلم داخل جماجمنا، ليس هو من ينتج الوعي بل هو مجرد جهاز استقبال أو وسيط له؟ هذه الأسئلة، التي كانت في صميم الفلسفة لقرون، تعود اليوم بقوة إلى الواجهة العلمية، مدفوعة بأدلة مذهلة من تجارب الاقتراب من الموت (Near-Death Experiences أو NDEs)، وهي ظاهرة تتحدى النموذج المادي السائد للعلم الحديث.
في محاضرة له، طرح المفكر عدنان إبراهيم هذه الإشكالية العميقة، مستعرضًا آراء كبار علماء الأعصاب وأحدث الأبحاث في هذا المجال، ليقدم رؤية بديلة للعلاقة بين الوعي والدماغ، رؤية قد تغير فهمنا للحياة والموت والوجود الإنساني نفسه.
لغز الإبصار: كيف نرى في صندوق مظلم؟
يبدأ الطرح من نقطة تبدو بديهية ولكنها في الحقيقة من أعقد الألغاز: كيف نبصر؟ يشير إبراهيم إلى حيرة عالم الأعصاب الشهير وايلدر بنفيلد (Wilder Penfield)، الذي قضى حياته في دراسة الدماغ، واعترف بأنه لا يوجد جواب علمي حقيقي لهذا السؤال. ما يحدث في عملية الإبصار هو أن الأشعة المنبعثة من الأجسام تسقط على شبكية العين، ثم ينقلها العصب البصري كإشارات كهربائية إلى الفص القذالي (Occipital Lobe) في مؤخرة الدماغ. هناك، في مكان معتم تمامًا لا يصله فوتون ضوء واحد، يتم “ترجمة” هذه الإشارات إلى صور غنية بالألوان والأبعاد والظلال.
التساؤل المحوري هو: كيف يمكن لكتلة من الخلايا العصبية في صندوق مظلم أن تخلق تجربة ذاتية ورؤية واعية للألوان والعالم الخارجي؟ هذا ما يُعرف في الفلسفة بـ “المشكلة الصعبة للوعي” (The Hard Problem of Consciousness). يرى الطرح المادي أن الوعي هو مجرد نتاج ثانوي للعمليات الكهروكيميائية في الدماغ، لكنه لا يفسر “كيف” أو “لماذا” تنشأ هذه التجربة الذاتية.
في مقابل هذا، تظهر نظريات جديدة مثل “العقل الممتد” (The Extended Mind) التي يدافع عنها علماء مثل روبرت شيلدريك (Rupert Sheldrake)، والتي تقترح أن وعينا وإدراكنا لا يقتصران على حدود الجمجمة، بل يمتدان إلى العالم الخارجي. هذا يتوافق مع تجربتنا الحسية المباشرة؛ فنحن نشعر بأننا نرى الأشياء “في مكانها” في الخارج، وليس كصورة داخل رؤوسنا.
شهادة من قمة علم الأعصاب: الدماغ ليس المُنتِج
لم تكن هذه الأفكار حكرًا على الفلاسفة. يستشهد إبراهيم بثلاثة من أعظم علماء الدماغ والأعصاب في القرن العشرين، الذين توصلوا في نهاية حياتهم المهنية إلى استنتاجات مشابهة:
- تشارلز شيرينغتون (Charles Sherrington): الحائز على جائزة نوبل وأبو علم وظائف الأعضاء العصبية الحديث.
- جون إيكلس (John Eccles): حائز على جائزة نوبل لأبحاثه حول المشابك العصبية.
- وايلدر بنفيلد (Wilder Penfield): أشهر جراح أعصاب في عصره.
هؤلاء العمالقة، بعد عقود من البحث في الدماغ، تبنوا نموذجًا لا ماديًا (Non-Materialist) لعلاقة الوعي بالدماغ. خلصوا إلى أن الدماغ لا “ينتج” الوعي، بل يعمل “كميسّر” أو “وسيط” له. يُعرف هذا بـ “نموذج التيسير” (Facilitation Model) أو “نموذج الإرسال” (Transmission Model). العلاقة بينهما ليست علاقة إنتاج سببي، بل علاقة تيسير وتسهيل. الحواس والجهاز العصبي هي أدوات تُمكّن الوعي (الذي يُعتقد أنه كيان مستقل) من التفاعل مع العالم المادي.
تجارب الاقتراب من الموت: الدليل القاطع؟
إذا كان الوعي منفصلاً عن الدماغ، فهل يمكنه العمل بدونه؟ هنا تبرز أهمية تجارب الاقتراب من الموت كدليل ميداني. هذه التجارب تحدث لأشخاص يكونون في حالة موت سريري (توقف القلب والتنفس) أو حتى موت دماغي (توقف النشاط الكهربائي للدماغ بشكل كامل). ورغم أن أجهزتهم الحيوية متوقفة، يروي العديد منهم بعد عودتهم للحياة تجارب واعية ومنظمة، مثل:
- الانفصال عن الجسد ورؤية الغرفة والفريق الطبي من منظور علوي.
- سماع ورؤية أحداث وقعت في أماكن أخرى من المستشفى أو حتى خارجه.
- وصف تفاصيل دقيقة تم التحقق من صحتها لاحقًا.
هذه الظاهرة دفعت عددًا متزايدًا من الأطباء والعلماء إلى دراستها بجدية. من أبرزهم الدكتور الهولندي بيم فان لوميل (Pim van Lommel)، الذي نشر دراسة استباقية شهيرة في مجلة The Lancet عام 2001. خلصت الدراسة التي شملت ناجين من سكتات قلبية إلى أن النموذج المادي الحالي عاجز عن تفسير هذه التجارب.
تفنيد الاعتراضات المادية
يقدم النموذج المادي عدة تفسيرات محتملة لهذه التجارب، لكنها تبدو قاصرة عند فحصها بعمق:
- نقص الأكسجة (Anoxia): يُعتقد أن نقص الأكسجين في الدماغ يسبب هلوسات. لكن هذا التفسير يسقط أمام عدة حقائق:
- تجارب الاقتراب من الموت غالبًا ما تكون شديدة الوضوح والمنطقية، على عكس الهلوسات المشوشة الناتجة عن نقص الأكسجة.
- الأهم من ذلك، لا يفسر نقص الأكسجة كيف يمكن للمريض أن يرى ويصف أحداثًا حقيقية وقعت خارج نطاق حواسه الجسدية، وأحيانًا في أماكن بعيدة.
- تحدث هذه التجارب أيضًا في حالات لا تتضمن نقص الأكسجة، مثل حالات الحزن الشديد، أو الاكتئاب، أو حتى التأمل العميق.
-
الهلوسات (Hallucinations): يصف الأطباء الهلوسات الناتجة عن الأمراض أو العقاقير بأنها غير متماسكة، وغالبًا ما تُنسى تفاصيلها بسرعة. على النقيض، يتذكر أصحاب تجارب الاقتراب من الموت تجاربهم بوضوح تام حتى بعد مرور عقود، ويصفونها بأنها “أكثر واقعية من الواقع”. علاوة على ذلك، الهلوسات هي تجارب ذاتية بحتة، بينما تحتوي تجارب الاقتراب من الموت على معلومات موضوعية يمكن التحقق منها.
-
هلوسة الإسقاط الذاتي (Autoscopic Hallucination): هي حالة عصبية نادرة يرى فيها الشخص نسخة من نفسه. لكن الدراسات العصبية، مثل مراجعة شاملة نشرت في مجلة Brain، تظهر أن هذه الظاهرة تختلف جذريًا عن تجارب الاقتراب من الموت. ففيها يرى المريض غالبًا جذعه فقط ومن زاوية محددة، بينما في تجربة الاقتراب من الموت، يرى الشخص جسده بالكامل والبيئة المحيطة بزاوية 360 درجة، مع إدراك كامل لما يحدث.
- العزلة (Isolation): يُقال إن العزلة الشديدة (مثل حالة الناجين من غرق السفن) قد تسبب هلوسات. هذا التفسير لا ينطبق لأن تجارب الاقتراب من الموت تحدث بشكل مفاجئ وفي فترات زمنية قصيرة جدًا. الطبيب النفسي جون ليلي (John Lilly) في كتابه “مركز الإعصار” (The Center of the Cyclone)، وصف تجربته الشخصية مع الانفصال عن الجسد التي خاضها طوعيًا، وأكد أنها تختلف تمامًا عن أي حالة هلوسة معروفة.
البرهان الذي لا يُدحض: الإدراك خارج الجسد
الدليل الأقوى الذي يقدمه المدافعون عن حقيقة هذه التجارب هو “الإدراك الحقيقي خارج الجسد” (Veridical Out-of-Body Perception). وهو قدرة الشخص أثناء موته السريري على إدراك أحداث لم يكن من الممكن لحواسه الجسدية التقاطها. يروي إبراهيم قصة موثقة عن رجل رأى أثناء وجوده تحت الإنعاش شقيقه وهو يُمنع من دخول المستشفى، ووصف دموعه وحديثه مع جندي كان يشعل نارًا في الشارع. كل هذه التفاصيل تم تأكيدها لاحقًا. كيف يمكن لدماغ “ميت” أن يلتقط هذه المعلومات؟
هذا النوع من الأدلة هو ما دفع علماء مثل الدكتور سام بارنيا (Sam Parnia)، مدير أبحاث الإنعاش القلبي الرئوي في جامعة ستوني بروك، إلى إطلاق مشروع AWARE البحثي، الذي يهدف إلى دراسة الوعي أثناء السكتة القلبية بشكل علمي صارم.
نماذج لفهم العلاقة: الدماغ كجهاز استقبال
لتبسيط الفكرة، تُستخدم عدة تشبيهات لوصف دور الدماغ كوسيط وليس كمنتج:
- التلفزيون والراديو: إذا حطمت جهاز التلفزيون، فلن تتوقف المباراة أو ينقطع البث. الجهاز هو مجرد “مستقبل” يحول الموجات الكهرومغناطيسية غير المرئية إلى صور وأصوات. وبالمثل، موت الدماغ قد لا يعني نهاية الوعي، بل توقف “جهاز الاستقبال” عن العمل.
- مجاز المرآة (كهف أفلاطون): تخيل شخصًا مقيدًا طوال حياته بحيث لا يرى إلا انعكاسات العالم الحقيقي على مرآة أمامه. سيظن أن هذه الانعكاسات هي الواقع كله. إذا كُسرت المرآة، سيظن أن العالم قد انتهى، بينما الحقيقة أن العالم الحقيقي كان دائمًا وراءه. البدن، في هذا المجاز، هو المرآة العاكسة للوعي.
- بدالة الهاتف (هنري برغسون): الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون (Henri Bergson)، في كتابه “المادة والذاكرة”، شبه الدماغ ببدالة الهاتف التي لا تخلق الرسائل أو المتصلين، بل تقتصر مهمتها على توصيلهم وتسهيل التواصل.
هذه النماذج، وإن كانت تبسيطية، تساعد على تصور إمكانية وجود الوعي ككيان مستقل يستخدم الدماغ كأداة للتفاعل مع العالم المادي. وهذا المفهوم ليس غريبًا على التقاليد الروحية القديمة، مثل مفهوم “النفس” (Atman) في الفلسفة الهندوسية، أو “الروح” في الأديان الإبراهيمية، التي لطالما رأت أن جوهر الإنسان شيء يتجاوز الجسد المادي.
خلاصة وتطلع للمستقبل
إن الأدلة المتراكمة من أبحاث تجارب الاقتراب من الموت، والتي يقودها علماء مرموقون مثل بيم فان لوميل، وسام بارنيا، وبروس غريسون (Bruce Greyson)، وماريو بورغارد (Mario Beauregard)، تشير بقوة إلى أن النموذج المادي الحالي للعقل قاصر. هؤلاء العلماء لا يقدمون إجابات نهائية، بل يطرحون أسئلة جريئة ويدعون إلى توسيع نطاق البحث العلمي ليشمل ظواهر كانت تُعتبر خارج حدوده.
كما ذكر الدكتور بيم فان لوميل في ختام دراسته، “ما من مقاربة دوائية أو فيزيولوجية أو نفسية قادرة على تفسير هذه الحالات”. يبدو أننا على أعتاب ثورة علمية جديدة، أو “تحول نموذجي” (Paradigm Shift)، قد يستغرق عقودًا، لكنه سيفرض نفسه في النهاية، ليقدم لنا فهمًا أعمق وأشمل للوعي ومكانتنا في الكون.
تنبيه: هذا المقال يلخص آراء خبراء ودراسات متاحة لأغراض تثقيفية فقط، ولا يعتبر نصيحة طبية.