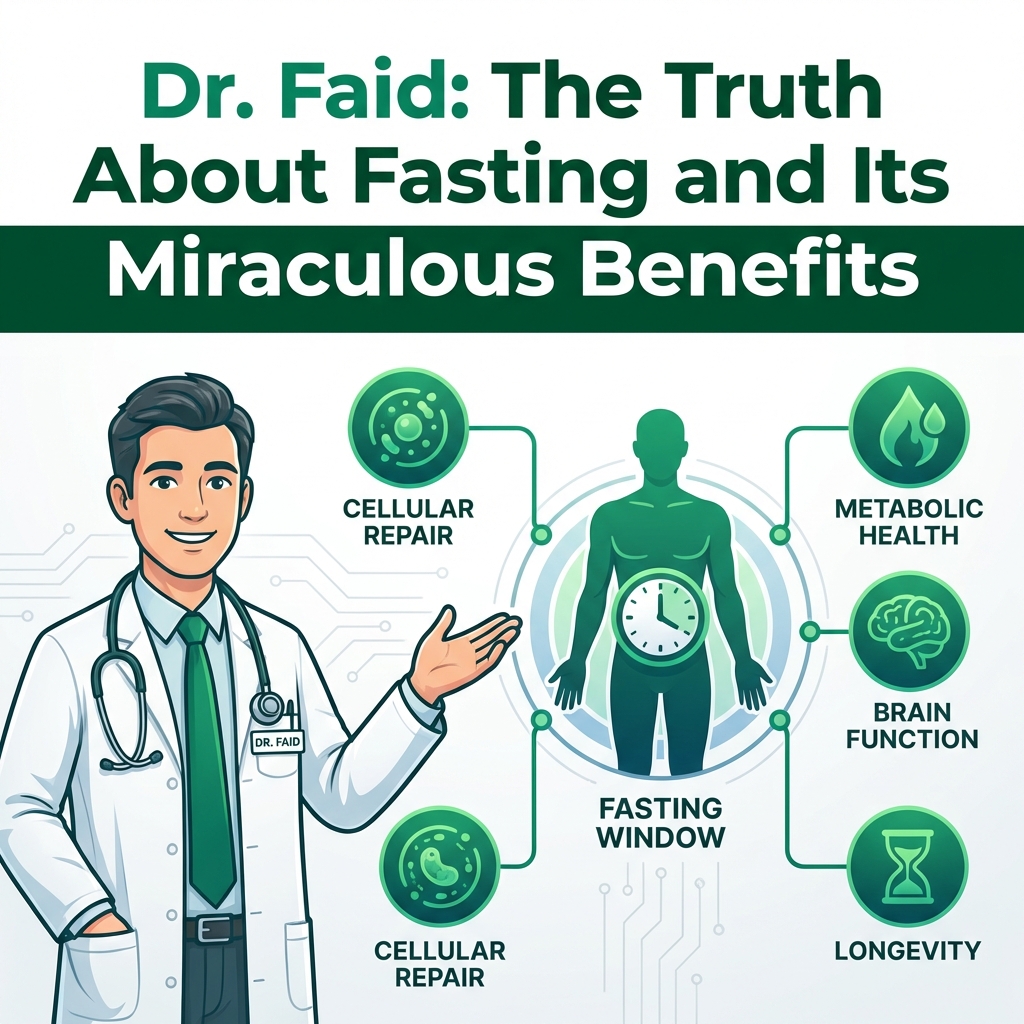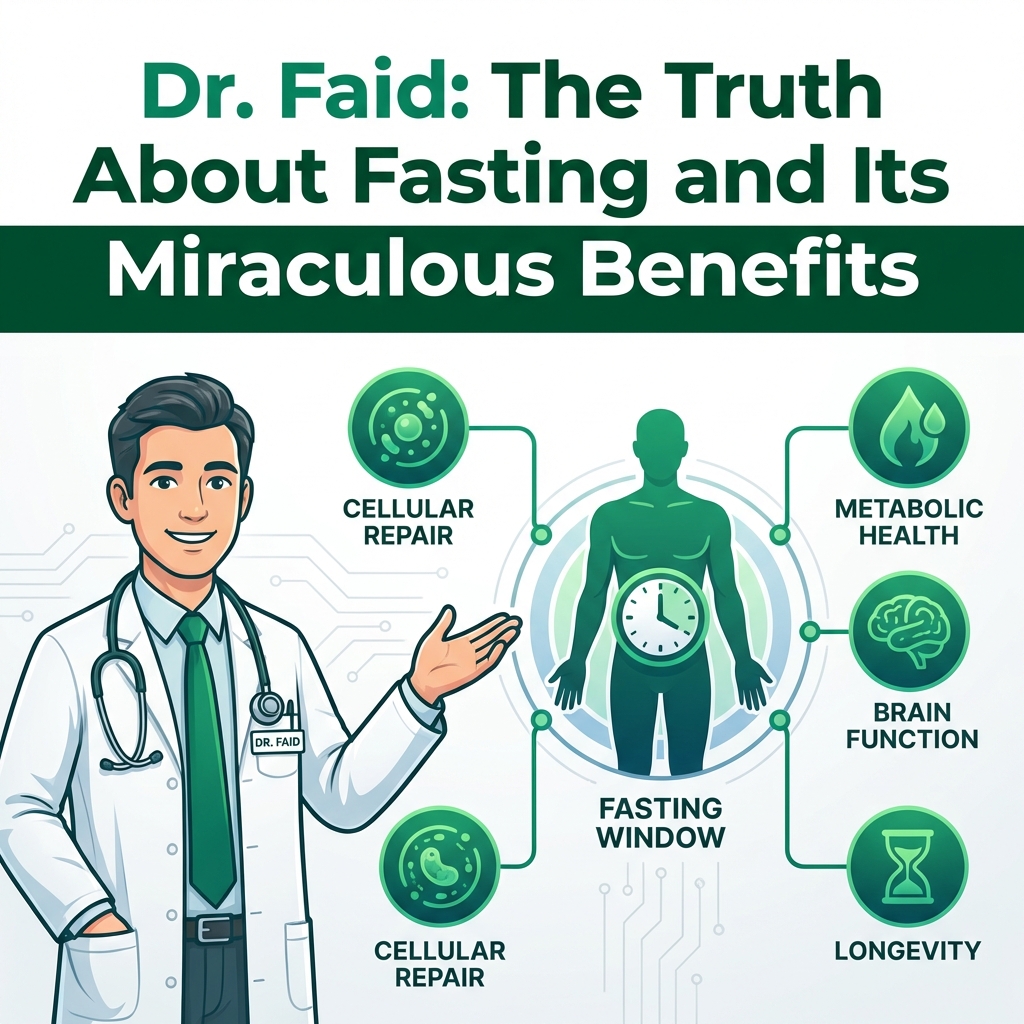هل يمكن أن يكون كل ما نراه حولنا، من أصغر ذرة إلى أضخم مجرة، قد وُلد من نقطة واحدة متناهية في الصغر، في لحظة زمنية لا يمكن للعقل البشري استيعابها؟ في مقطع فيديو حديث على يوتيوب، يأخذنا متحدث في رحلة عبر الزمن إلى أصل كل شيء، مستعرضًا القصة المذهلة لنشأة الكون، وهي قصة لا تزال تثير فضول العلماء وتدفعهم إلى حدود المعرفة. إنها قصة الانفجار العظيم، النظرية التي غيرت فهمنا للوجود، والتي تكشف عن تصميم كوني دقيق بشكل لا يصدق.
في حديثه، يوضح المتحدث أن مصطلح “الانفجار العظيم” (The Big Bang) قد يكون مضللًا بعض الشيء. فالأمر لم يكن انفجارًا لقنبلة في مكان فارغ، بل كان توسعًا مفاجئًا وسريعًا لنسيج الزمكان (Spacetime) نفسه. قبل هذه اللحظة، لم يكن هناك “مكان” أو “زمان” كما نعرفهما. كانت كل طاقة ومادة الكون محصورة في نقطة واحدة تُعرف باسم “نقطة التفرد” (Singularity)، وهي حالة من الكثافة والحرارة اللانهائيتين. لفهم مدى كثافتها، يتحدى المتحدث المستمعين أن يتخيلوا ضغط كل مادة جبل إيفرست في حجم حبة رمل واحدة. هذه الكثافة الهائلة كانت هي الحالة الطبيعية للكون في بدايته.
عصر بلانك والقوة الموحدة
يغوص المتحدث في اللحظات الأولى من عمر الكون، وتحديدًا في “عصر بلانك” (Planck Epoch)، وهو جزء من الثانية لا يمكن تصوره، يمتد حتى 10 قوة سالب 43 ثانية بعد البداية. في هذه اللحظة، كانت القوى الأساسية الأربع في الطبيعة التي نعرفها اليوم — الجاذبية، والكهرومغناطيسية، والقوة النووية القوية، والقوة النووية الضعيفة — متحدة في قوة واحدة عظمى. كانت قوانين الفيزياء التي تحكم عالمنا اليوم قد انهارت تمامًا.
تدعم النماذج الفيزيائية الحديثة، مثل “نظرية الأوتار” (String Theory) و”الجاذبية الكمومية الحلقية” (Loop Quantum Gravity)، فكرة أن فهم هذه الحقبة يتطلب دمج نظرية النسبية العامة لأينشتاين مع ميكانيكا الكم، وهو ما يُعرف بـ “نظرية كل شيء” (Theory of Everything) التي لم يصل إليها العلماء بعد. تشير مراجعة علمية منشورة في مجلة Nature إلى أن هذه الفترة المبكرة هي أحد أكبر الألغاز في الفيزياء الحديثة، وأن أي تقدم في فهمها سيمثل ثورة في العلم.
التضخم الكوني: كيف اقترض الكون طاقته من العدم؟
بعد عصر بلانك مباشرة، دخل الكون في مرحلة حاسمة تُعرف بـ “عصر التضخم” (Inflationary Epoch) حوالي 10 قوة سالب 35 ثانية بعد البداية. خلال هذه الفترة، تضخم الكون بشكل أُسّي ومذهل، حيث زاد حجمه بمعامل 10 قوة 26 على الأقل في جزء ضئيل من الثانية. يوضح المتحدث أن هذا التضخم هو الذي يفسر لماذا يبدو الكون اليوم مسطحًا ومتجانسًا (Homogeneous) على نطاقات واسعة.
تم اقتراح نظرية التضخم لأول مرة من قبل الفيزيائي آلان غوث في عام 1981 لحل بعض المشاكل في نموذج الانفجار العظيم القياسي، مثل “مشكلة الأفق” و”مشكلة التسطيح”. وقد تم تأكيد تنبؤات هذه النظرية بشكل كبير من خلال ملاحظات “إشعاع الخلفية الكونية الميكروي” (CMB). وجدت دراسات أجراها مرصد بلانك الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، أن التقلبات الطفيفة في درجة حرارة هذا الإشعاع تتطابق تمامًا مع ما تتنبأ به نماذج التضخم.
من الأفكار المذهلة التي يطرحها المتحدث هي أن الكون “اقترض” الطاقة اللازمة لهذا التوسع الهائل من العدم، ثم “سدد الدين” عن طريق خلق الجاذبية، التي تمثل طاقة سلبية توازن الطاقة الإيجابية للمادة. هذا المفهوم، المتجذر في فيزياء الكم، يشير إلى أن الطاقة الكلية للكون قد تكون صفرًا.
ولادة المادة: لغز الاختفاء المحيّر
مع انتهاء التضخم، تحولت الطاقة الهائلة إلى “شوربة كونية” (Cosmic Soup) من الجسيمات الأولية مثل الكواركات (Quarks)، والإلكترونات (Electrons)، والفوتونات (Photons). كانت الحرارة عالية جدًا لدرجة أن المادة والمادة المضادة (Antimatter) كانتا تتشكلان وتفنيان بعضهما البعض باستمرار. نظريًا، كان يجب أن يؤدي هذا “الإفناء المتبادل” (Mutual Annihilation) إلى فناء كل المادة، تاركًا وراءه كونًا مليئًا بالطاقة (الفوتونات) فقط.
لكن، كما يشير المتحدث، لسبب لا يزال غامضًا، كان هناك اختلال طفيف جدًا: مقابل كل مليار جسيم من المادة المضادة، كان هناك مليار وجسيم واحد من المادة. هذه الزيادة البسيطة هي التي شكلت كل شيء في الكون الذي نعرفه اليوم، من النجوم والمجرات إلى الكواكب والحياة نفسها. يُعرف هذا اللغز باسم “عدم تناظر الباريون” (Baryon Asymmetry)، وهو أحد أكبر الأسئلة المفتوحة في الفيزياء. تجري تجارب في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN) لمحاولة فهم سبب هذا الاختلال، لكن الإجابة النهائية لم تظهر بعد.
الدقائق الثلاث الأولى: وصفة الكون الكيميائية
بعد حوالي دقيقة واحدة من البداية، برد الكون بما يكفي لتتجمع الكواركات معًا لتكوين البروتونات والنيوترونات. وبعد ثلاث دقائق، اتحدت هذه البروتونات والنيوترونات في عملية تُعرف بـ “التخليق النووي الأولي” (Big Bang Nucleosynthesis) لتكوين أول نوى ذرية. كانت النتيجة، كما يذكر المتحدث، كونًا يتكون من حوالي 75% من الهيدروجين و25% من الهيليوم، مع كميات ضئيلة جدًا من الليثيوم.
تعتبر هذه النسب من أقوى الأدلة على صحة نظرية الانفجار العظيم. تتطابق تنبؤات النظرية بشكل مذهل مع قياسات وفرة هذه العناصر في أقدم النجوم والمجرات التي نرصدها اليوم، كما تؤكد مراجعة شاملة من جامعة شيكاغو.
يشير المتحدث إلى نقطة مهمة تتعلق بـ “الضبط الدقيق للكون” (Fine-Tuning of the Universe). لو كان معدل تبريد الكون أبطأ قليلًا، لكانت كل النوى قد اندمجت لتكوين عناصر أثقل مثل الكربون، ولم يكن ليتبقى وقود هيدروجيني لتشتعل به النجوم لاحقًا. هذا التوازن الدقيق هو أحد الجوانب التي تذهل العلماء وتدفع البعض للتساؤل عن وجود تصميم ذكي وراء الكون. يتفق العديد من الفيزيائيين، مثل بول ديفيز (Paul Davies)، على أن وجود الحياة يعتمد بشكل حاسم على قيم الثوابت الفيزيائية الأساسية التي تبدو وكأنها “مضبوطة” بدقة متناهية.
عصر الظلام وأول ضوء في التاريخ
بعد تكوين النوى، دخل الكون في “عصر الظلام الكوني” (Cosmic Dark Ages) الذي استمر لحوالي 380,000 عام. كان الكون عبارة عن بلازما (Plasma) ساخنة وكثيفة من النوى والإلكترونات الحرة. كانت هذه “الشوربة” معتمة تمامًا، حيث كانت الفوتونات (جسيمات الضوء) تتشتت باستمرار عند اصطدامها بالإلكترونات الحرة، وغير قادرة على السفر لمسافات طويلة.
انتهى هذا العصر عندما برد الكون إلى حوالي 3000 كلفن، وهي درجة حرارة منخفضة بما يكفي لتتمكن النوى من “أسر” الإلكترونات وتكوين أول ذرات متعادلة كهربائيًا. تُعرف هذه اللحظة بـ “إعادة الاتحاد” (Recombination). عندها، أصبح الكون شفافًا فجأة، وانطلقت الفوتونات التي كانت محتجزة بحرية في جميع الاتجاهات. هذا الضوء الأول هو ما نعرفه اليوم باسم “إشعاع الخلفية الكونية الميكروي” (CMB).
اكتُشف هذا الإشعاع بالصدفة في عام 1965 من قبل آرنو بنزياس وروبرت ويلسون، وهو ما منحهما جائزة نوبل في الفيزياء. وكما يذكر المتحدث، فإن حوالي 1% من التشويش الذي تسمعه على راديو تناظري قديم بين المحطات هو في الواقع صدى هذا الضوء الأول. لقد قدمت الأقمار الصناعية مثل COBE وWMAP وPlanck خرائط مفصلة لهذا الإشعاع، والتي كشفت عن “بذور” التراكيب الكونية التي نمت لتصبح مجرات وعناقيد مجرية.
العدم الكمومي والتوافق المذهل
يطرح المتحدث سؤالًا فلسفيًا وعلميًا عميقًا: هل كان هناك “عدم” حقيقي قبل الشرارة الأولى؟ تجيب فيزياء الكم بأن العدم المطلق غير موجود. حتى في الفضاء الفارغ تمامًا، هناك ما يسمى بـ “طاقة نقطة الصفر” (Zero-Point Energy)، وهي طاقة كامنة في الفراغ نفسه، تؤدي إلى ظهور “جسيمات افتراضية” (Virtual Particles) تختفي وتظهر في ومضة. هذه الظاهرة ليست مجرد نظرية، بل لها تأثيرات قابلة للقياس مثل “تأثير كازيمير” (Casimir Effect)، حيث تنجذب صفيحتان معدنيتان متوازيتان في الفراغ بسبب ضغط هذه الجسيمات الافتراضية.
في هذا السياق، يلفت المتحدث الانتباه إلى ما يراه توافقًا مدهشًا بين الاكتشافات العلمية الحديثة والنص القرآني. يستشهد بالآية 30 من سورة الأنبياء: “أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا”. يفسر المتحدث كلمة “رتقًا” بأنها تصف حالة الوحدة والالتصاق التام (نقطة التفرد)، وكلمة “فتقناهما” بأنها تصف عملية الفصل والتوسع (الانفجار العظيم). هذا الربط بين النص الديني والنظرية العلمية هو موضوع اهتمام كبير لدى مفكرين مثل الدكتور زغلول النجار والدكتور مصطفى محمود، اللذين بحثا في أوجه الإعجاز العلمي في القرآن.
من المثير للاهتمام أن فكرة الخلق من حالة أولية من الوحدة أو الفوضى تظهر في العديد من التقاليد القديمة الأخرى. في الأساطير المصرية القديمة، نشأ الكون من محيط فوضوي أولي يسمى “نون”. وفي الأساطير الصينية، وُلد كل شيء من بيضة كونية. هذه التشابهات الثقافية قد تعكس فهمًا بشريًا فطريًا بأن التعقيد والنظام ينشأان من البساطة والوحدة.
في الختام، يقدم الفيديو رحلة ملحمية عبر تاريخ الكون، من لحظة غامضة قبل الزمان والمكان إلى ولادة الضوء والمادة. إنها قصة تكشف عن كون محكوم بقوانين دقيقة بشكل مذهل، حيث أدت زيادة طفيفة في المادة إلى وجودنا، وحيث أن الضبط الدقيق لسرعة التبريد سمح للنجوم بالاشتعال. سواء نظرنا إليها من منظور علمي بحت أو من خلال عدسة إيمانية، تظل قصة نشأة الكون هي أعظم قصة على الإطلاق، قصة تدعونا للتفكر في مكانتنا في هذا الوجود الشاسع والمذهل.
تنويه: هذا المقال يلخص آراء الخبراء والدراسات المتاحة لأغراض تعليمية وتثقيفية فقط، ولا يعتبر استشارة طبية.