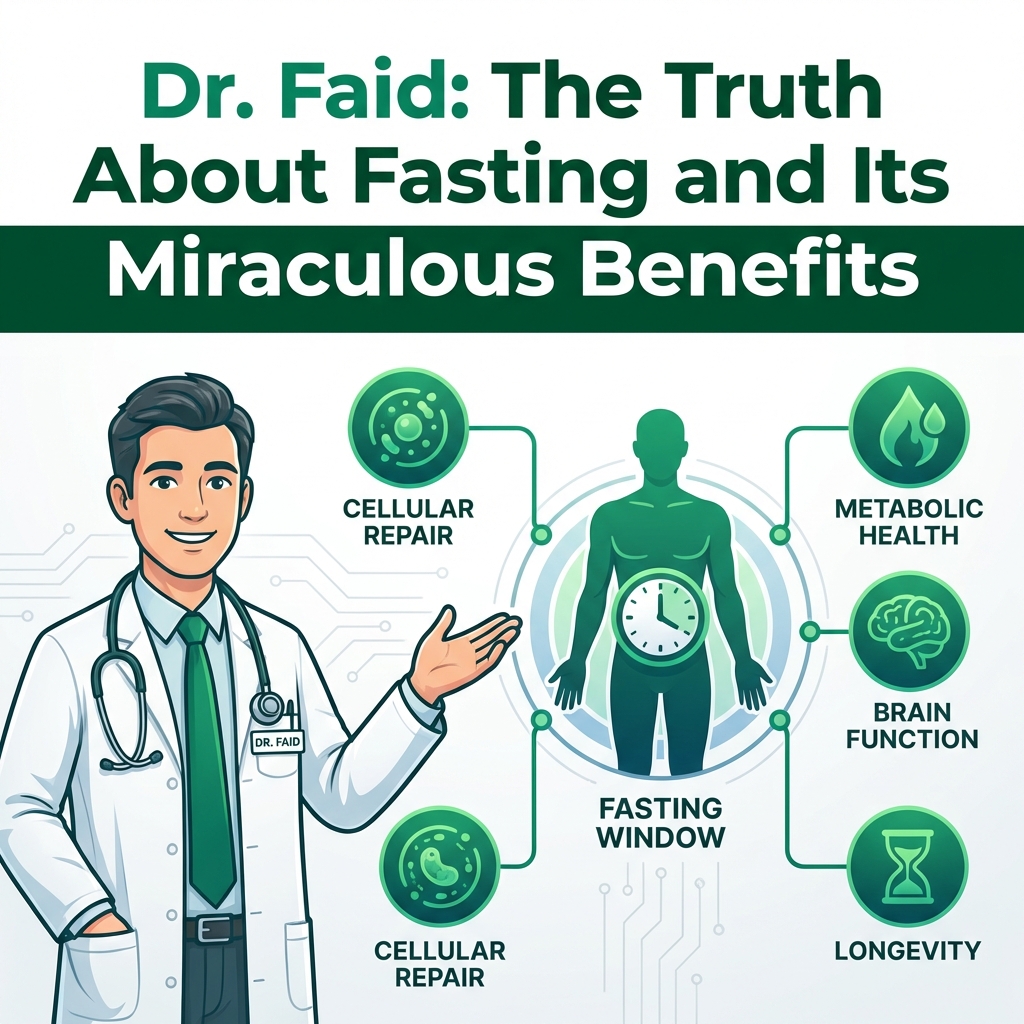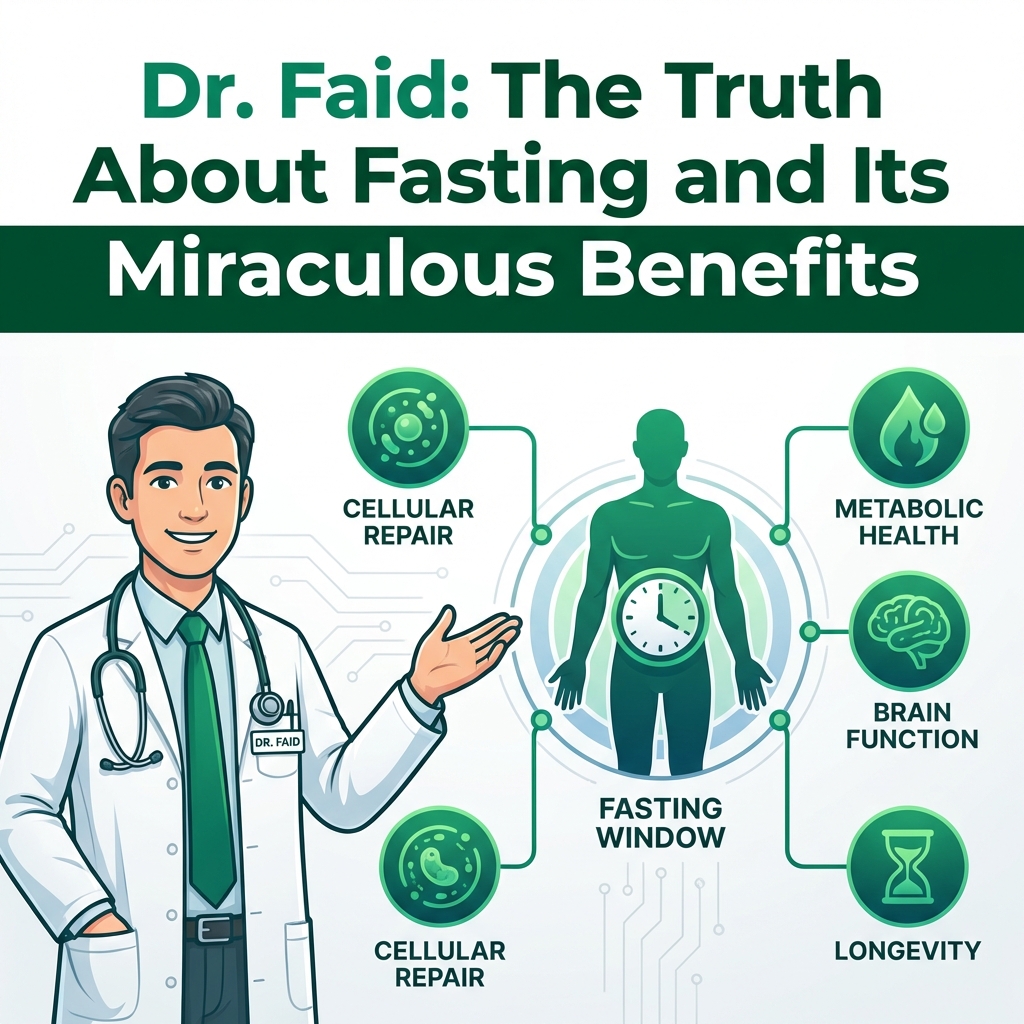قد يبدو وجود الآفات والأمراض والأعداء شراً مطلقاً، لكن ماذا لو كان هذا الصراع جزءاً من تصميم كوني محكم وهادف؟ في محاضرة عميقة، طرح أحد المتحدثين رؤية فلسفية وإيمانية تستند إلى القرآن الكريم، مفادها أن الصراع والتناقض ليسا حادثاً عرضياً، بل هما “سُنّة كونية” أرادها الله لتحقيق حِكمٍ بالغة، أهمها إقامة توازن دقيق يضمن استمرارية الحياة ويمنع طغيان قوة على أخرى.
كل شيءٍ خُلق له نقيض
في تأمل لافت للنظر، يبدأ المتحدث بالإشارة إلى أن الله قد خلق لكل شيء في الوجود آفةً أو نقيضاً يعتدي عليه. فالقطن له دودة القطن، والنبات له الجراد، والثمرة يقابلها العفن، والحديد يقابله الصدأ. ويمتد هذا المبدأ ليشمل الكائن البشري نفسه؛ فالأنف يُبتلى بالزكام، والأسنان بالسوس، والمفاصل بالروماتيزم. بل إن الإنسان نفسه يواجه جيشاً من الأعداء، من الحشرات والنمل والصراصير إلى الميكروبات والفيروسات، كلها تتحالف عليه.
هذه الحقيقة، كما يوضح المتحدث، ليست سراً أخفاه الله، بل أعلنها بوضوح في القرآن الكريم. ففي سورة البلد، يقول تعالى: “لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ” (البلد: 4)، أي في مشقة ومكابدة مستمرة. ويأتي التأكيد بشكل أكثر تفصيلاً في سورة الفرقان: “وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ” (الفرقان: 31)، وإذا كان هذا حال الأنبياء، وهم صفوة الخلق، فما بالك ببقية البشر؟ بل إن هذه العداوة متأصلة منذ بدء الخليقة، فعندما هبط آدم إلى الأرض، كان الأمر الإلهي واضحاً: “اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ” (البقرة: 36). إذن، نحن أمام قانون إلهي مقصود ومُدبّر.
الحكمة الأولى: امتحان المعادن وكشف الحقائق
يطرح المتحدث سؤالاً محورياً: ما الحكمة من هذه السنة الكونية؟ الإجابة الأولى تكمن في أنها وسيلة لامتحان معادن البشر وفرز الحق من الباطل، كما تشير الآية الكريمة: “فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ” (الرعد: 17). فكما يتم اختبار أنواع الخشب لتمييز الجيد الذي يُصنع منه الأثاث الفاخر من الرديء الذي يُستخدم في صناعة عصا مكنسة، وكما يتم اختبار صلابة الحديد لتحديد ما يصلح لصناعة المحركات والتوربينات وما يصلح للصفائح المعدنية الرخيصة، كذلك يُمتحن البشر من خلال الصراعات والمشقات.
قد يعترض البعض بالقول: “أليس الله عالماً بحقيقة كل إنسان؟” يجيب المتحدث بأن الله بالفعل عالم بكل شيء، لكن هذا الامتحان ليس لله، بل هو للبشر أنفسهم ليكتشفوا حقيقة ذواتهم. فكل إنسان يميل إلى رؤية نفسه كضحية مظلومة، وقد يظن أنه يستحق أفضل مما هو فيه. لذا، كان لا بد من هذا الاختبار العملي ليكشف كل فرد لنفسه حقيقته ومعدنه الأصيل.
هذه الفكرة تجد أصداءً في مدارس فلسفية أخرى. فالفلسفة الرواقية (Stoicism)، التي أسسها زينون الرواقي واعتنقها مفكرون مثل سينيكا وماركوس أوريليوس، ترى في المصاعب والعقبات فرصة لممارسة الفضيلة وتقوية الشخصية. فالعقبة في الطريق تصبح هي الطريق نفسه، والتحدي هو ما يصقل الروح ويظهر جوهرها.
الحكمة الثانية: دفع الفساد وتحقيق التوازن
الحكمة الثانية، كما يستنبطها المتحدث من القرآن، هي حفظ الأرض من الفساد عبر إقامة توازن بين القوى المتصارعة. يقول تعالى: “وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّasَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ” (البقرة: 251). فعندما يظهر طاغية متجبر، يُقيّض الله له جباراً آخر يصطدم به، وعندما تبرز قوة غاشمة، تظهر قوة أخرى لتواجهها. المثال التاريخي الذي يُطرح هو ظهور هتلر الذي قابله ظهور ستالين. لولا هذا التصادم، لكان بإمكان قوة واحدة مثل قوة هتلر، بكل هوسه حول نقاء الجنس الآري وسيادة الدم الأزرق، أن تنفرد بالعالم وتعامل بقية الشعوب كالحشرات.
هذا المبدأ معروف في العلوم السياسية الحديثة بـ “نظرية توازن القوى” (Balance of Power Theory)، التي يعتبرها منظرون مثل هانز مورغنثاو حجر الزاوية في العلاقات الدولية. تفترض النظرية أن السلام والاستقرار يتحققان ليس بوجود قوة مهيمنة واحدة، بل عندما تتوزع القوة بين عدة أطراف بحيث لا تستطيع أي جهة فرض إرادتها على الآخرين. هذا التوازن يمنع الاستبداد ويسمح للدول الأضعف بالبقاء والعيش.
الصراع في الفكر الفلسفي: من هيجل وماركس إلى الرؤية القرآنية
يشير المتحدث إلى أن القرآن الكريم سبق الفلاسفة بـ 1400 عام في الحديث عن مبدأ التناقض كقانون كوني. ففي الفلسفة الغربية، لم يظهر هذا المفهوم بوضوح إلا قبل حوالي 200 عام مع الفيلسوف الألماني جورج فيلهلم فريدريش هيجل، الذي تحدث عن الجدلية (Dialectic) في عالم الفكر. تقوم جدلية هيجل على أن كل فكرة (Thesis) تثير نقيضها (Antithesis)، ومن الصراع بينهما ينشأ تركيب جديد (Synthesis)، وهذا التركيب بدوره يصبح فكرة جديدة تثير نقيضها، وهكذا يتطور الفكر.
بعد هيجل، جاء كارل ماركس وطبّق هذا المبدأ على المادة والتاريخ فيما يُعرف بـ “الجدلية المادية” (Dialectical Materialism). رأى ماركس أن التاريخ يتحرك بفعل الصراع بين الطبقات الاجتماعية المتناقضة: صراع بين العبيد والإقطاعيين، ثم صراع بين العمال وأصحاب رأس المال. لكن ماركس لم يكتفِ بوصف هذا الصراع، بل دعا إلى إشعاله وتأجيجه للتعجيل بحركة التاريخ والوصول إلى مجتمع شيوعي خالٍ من الطبقات. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن القوانين الجدلية هي التي خلقت المادة نفسها وطورتها من ذرة إلى مجرة، وأخرجت عبقرياً مثل شكسبير من رحم المادة الصماء.
وهنا يبرز الفارق الجوهري بين الرؤية القرآنية ورؤية الفلاسفة، كما يلخصها المتحدث في نقاط:
- الشمولية مقابل الجزئية: تناول الفلاسفة التناقض بشكل جزئي (هيجل في الفكر، وماركس في المادة والتاريخ)، بينما يقدمه القرآن كسنة كونية شاملة لكل شيء.
- مخلوق أم خالق؟: اعتبر ماركس أن قوانين الجدل هي قوانين خالقة ومسيطرة على الكون. أما الرؤية القرآنية فتؤكد أن هذا القانون هو نفسه مخلوق لله، يستخدمه الله كأداة لتحقيق أهدافه.
- الهدف: التوازن أم الإبادة؟: هدف ماركس من تأجيج الصراع الطبقي هو أن تقضي طبقة على أخرى (البروليتاريا تقضي على البرجوازية). أما مراد الله من سنة التدافع فهو إقامة “توازن محمود” يسمح للجميع بالعيش، لا أن يقضي طرف على الآخر. فالهدف الإلهي هو التعايش في ظل توازن، بينما الهدف الماركسي هو الخراب والإبادة لتحقيق غاية أيديولوجية.
الدرس العملي: حرب الإنسان الخاسرة ضد الحشرات
يقدم المتحدث مثالاً معاصراً صارخاً يوضح خطأ المنهج الماركسي في التعامل مع الصراع: حرب الإنسان ضد الحشرات. لقد ارتكب الإنسان نفس خطأ ماركس، فأعلن “حرب إبادة” شاملة على الحشرات بهدف القضاء عليها تماماً. لكن النتيجة كانت كارثية وفشلًا ذريعًا.
فوجئ الإنسان بأن الحشرات لم تنقرض، بل طورت مناعة ومقاومة ضد كل مبيد كيميائي يستخدمه. ومع مرور الوقت، اضطر الإنسان إلى مضاعفة جرعات السموم للتغلب على هذه المقاومة المتزايدة. هذه الحلقة المفرغة أدت إلى عواقب وخيمة:
- تلوث شامل: تسربت كميات هائلة من السموم، مثل مركب الـ دي.دي.تي (DDT)، إلى أنسجة النباتات والفواكه، ولوثت المياه والتربة.
- التراكم البيولوجي (Bioaccumulation): انتقلت السموم عبر السلسلة الغذائية. أكلت المواشي نباتات ملوثة، فأصبحت لحومها وألبانها ملوثة. تلوثت الأسماك، وفي النهاية، وصل السم إلى جسم الإنسان. في إحدى الإحصائيات الصادمة التي ذكرها المتحدث، تم العثور على آثار الـ دي.دي.تي في حليب الأمهات المرضعات، مما يثبت أن السم أكمل دورته ليصل إلى اليد التي كانت ترشه. وقد أكدت دراسات علمية عديدة هذا الأمر، منها دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للصحة العامة (American Journal of Public Health) وجدت أن مركبات DDT ومشتقاتها لا تزال موجودة في حليب الأم في العديد من المناطق حول العالم حتى بعد عقود من حظرها، مما يدل على استمراريتها في البيئة.
أصبح الإنسان اليوم بين نارين: إما أن يتوقف عن استخدام المبيدات تماماً، فتلتهم الحشرات محاصيله في لمح البصر، أو يستمر في زيادة الجرعات، مع احتمال أن تطور الحشرات مقاومة مطلقة لكل السموم، فيهزم الإنسان وسلاحه في يده. هذه الظاهرة، المعروفة علمياً بـ “مقاومة المبيدات” (Pesticide Resistance)، هي نتيجة مباشرة لعملية الانتقاء الطبيعي، حيث تنجو الحشرات التي تمتلك طفرات جينية تسمح لها بتحمل السم، وتورث هذه الجينات لأجيالها التالية. وقد وصفتها مراجعة علمية في مجلة Nature بأنها “نتيجة حتمية للاستخدام الكيميائي”.
عظمة الحشرة وحكمة الخالق
يختتم المتحدث حديثه بالتأمل في عظمة تصميم الحشرات وقدرتها المذهلة على البقاء، والتي تتحدى كل التكنولوجيا البشرية. فالحشرات تكيفت مع جميع البيئات والمناخات، وتأكل كل شيء تقريباً، من الخشب إلى صدأ الحديد. يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية فوق الصفر و40 درجة تحت الصفر. وهي كائنات صغيرة لكن تأثيرها هائل: ذبابة واحدة يمكن أن تنشر وباء الكوليرا، وبعوضة واحدة يُعتقد أنها قتلت الإسكندر الأكبر بالملاريا في بابل، مما أدى إلى تفكك إمبراطoriته وتغير وجه التاريخ.
إن عجز الإنسان بكل علمه وتكنولوجيته عن إبادة حشرة صغيرة يثير سؤالاً عميقاً: كيف تكتسب الحشرة هذه المقاومة المعقدة؟ يرى المتحدث أن هذا لا يمكن أن يكون إلا “بإلهام إلهي وحكمة إلهية”. فالغدد والآليات البيوكيميائية المعقدة داخل جسم الحشرة التي تبطل مفعول السموم هي دليل على وجود إرادة عليا تضمن عدم إفناء طرف لآخر.
هذه الرؤية تتناغم مع بعض جوانب الفلسفة الشرقية، مثل مفهوم “وو وي” (Wu Wei) في الطاوية، الذي يدعو إلى العمل المنسجم مع طبيعة الأشياء بدلاً من فرض السيطرة بالقوة. فكما أن الماء، وهو ألين الأشياء، يتغلب على الصخر الأصلب، فإن القوة الحقيقية لا تكمن في المواجهة العنيفة بل في المرونة والتكيف.
في النهاية، الدرس المستفاد هو أن سنة الصراع والتدافع ليست دعوة للخراب، بل هي دعوة لفهم قوانين التوازن التي تحكم الكون. إن مراد الله ليس أن يقضي القوي على الضعيف، بل أن يعيش الجميع في توازن ديناميكي دقيق، حيث لكل كائن، مهما بدا ضئيلاً، دور ومكان في خريطة الحياة المعقدة.
تنويه: هذا المقال يلخص آراء المتحدث والدراسات المتاحة لأغراض تعليمية وتثقيفية فقط، ولا يعتبر استشارة طبية.