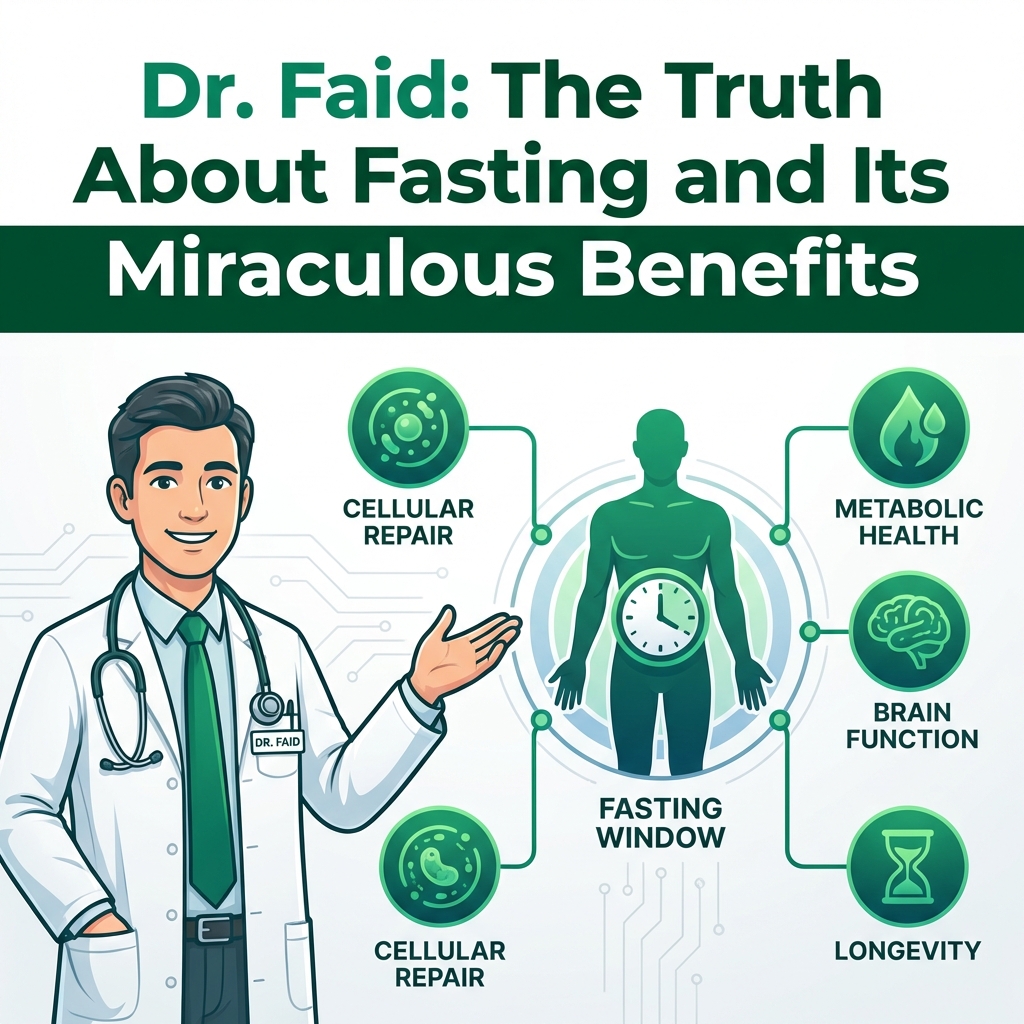ماذا لو كانت الحرية، أثمن ما يطمح إليه الإنسان، هي نفسها العبء الذي لا يُطاق؟ قد تبدو هذه الفكرة متناقضة، لكنها تكمن في صميم واحدة من أعمق الأزمات التي تواجه البشرية: أزمة المعنى. في حلقة من برنامجه على يوتيوب، يستعرض أحمد الغندور، المعروف بـ “الدحيح”، هذه الإشكالية المعقدة، متخذًا من شخصية “بروكس هاتلن” من فيلم “The Shawshank Redemption” مدخلاً لاستكشاف عالم الفلسفة الوجودية وأسئلتها المقلقة حول الحياة والغاية والاختيار.
تبدأ القصة مع “بروكس”، السجين الذي قضى 50 عامًا خلف القضبان، وعندما يحصل أخيرًا على حريته، لا يشعر بالفرح، بل بالرعب. يضع سكينًا على رقبة سجين آخر في محاولة يائسة للعودة إلى المكان الوحيد الذي يعرفه. وعندما يخرج إلى العالم الخارجي، يجده مكانًا غريبًا وسريعًا ومخيفًا. أبسط المهام، مثل ركوب الحافلة أو تعبئة أكياس البقالة، تصبح مصادر قلق هائلة. في النهاية، ينهي “بروكس” حياته، تاركًا وراءه رسالة موجزة ومؤلمة: “بروكس كان هنا”. هذه القصة المأساوية ليست مجرد دراما سينمائية، بل هي تجسيد لحالة نفسية حقيقية تُعرف بـ “متلازمة المأسسة” (Institutional Syndrome)، وهي حالة يعجز فيها الفرد عن التكيف مع الحياة خارج بيئة منظمة بالكامل كالسجن أو الجيش، حيث تكون جميع قراراته اليومية محددة مسبقًا.
عند البحث عن أدلة علمية، نجد أن هذه الظاهرة موثقة جيدًا في علم النفس. دراسة منشورة في “Journal of Offender Rehabilitation” عام 2019 (دراسة حالة ومراجعة) وجدت أن السجناء الذين قضوا فترات طويلة في السجن يواجهون صعوبات هائلة في إعادة الاندماج، ليس فقط بسبب الوصمة الاجتماعية، ولكن بسبب فقدان القدرة على اتخاذ القرارات المستقلة. الحرية، التي تبدو كهدف أسمى، تتحول إلى فراغ مرعب مليء بالخيارات التي لا نهاية لها، وهو ما أشار إليه عالم النفس باري شوارتز في كتابه “مفارقة الاختيار” (The Paradox of Choice)، حيث يوضح أن كثرة الخيارات لا تؤدي بالضرورة إلى سعادة أكبر، بل قد تسبب الشلل والقلق. “بروكس” لم يكن خائفًا من العالم، بل كان خائفًا من الحرية المطلقة التي فرضت عليه فجأة.
هذه الأزمة لا تقتصر على السجناء. يتناول “الدحيح” كيف يمكن أن تظهر في حياتنا اليومية، خاصة عندما نفقد الأدوار التي تُعرّف هويتنا. الموظف الذي يتقاعد بعد 40 عامًا من العمل، أو المعلم الذي يجد أن المادة التي يدرسها لم تعد ذات أهمية، كلاهما يواجه فراغًا مشابهًا. الهوية التي كانت مرتبطة بالوظيفة (“أنا مهندس”، “أنا طبيب”) تتلاشى، ويظهر السؤال المقلق: “من أنا الآن؟”. هذا الفقدان للهوية يمكن أن يؤدي إلى أزمات نفسية حادة. تؤكد الأبحاث في علم النفس المهني، مثل مراجعة منهجية (meta-analysis) نشرت في “Journal of Occupational Health Psychology”، أن التقاعد غير المخطط له أو فقدان الوظيفة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة معدلات الاكتئاب والقلق، لأن العمل غالبًا ما يوفر هيكلًا اجتماعيًا وشعورًا بالغاية والمعنى.
هنا، تدخل الفلسفة الوجودية كمحقق خاص في “جريمة” فقدان المعنى. يطرح الفلاسفة الوجوديون أن القلق الذي شعر به “بروكس” ليس مجرد حالة نفسية، بل هو جزء أساسي من التجربة الإنسانية. إنهم يواجهون الأسئلة الكبرى: لماذا نحن هنا؟ وما معنى الحياة؟
جان بول سارتر وعبء الحرية
كان الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر من أبرز من تناولوا هذه القضية. في محاضرته الشهيرة “الوجودية مذهب إنساني”، طرح فكرته المحورية: “الوجود يسبق الماهية”. على عكس القلم الذي صُنِع لغرض محدد (الكتابة) قبل أن يوجد، يرى سارتر أن الإنسان يولد أولاً، ثم من خلال اختياراته وأفعاله، يصنع ماهيته (كينونته وغايته). نحن نُلقى في هذا العالم دون “كتالوج” أو دليل إرشادي، ومحكوم علينا أن نكون أحرارًا. هذه الحرية ليست نعمة بقدر ما هي مسؤولية ساحقة. عندما نتهرب من هذه المسؤولية ونقبل بتعريفات جاهزة تفرضها علينا وظائفنا أو مجتمعاتنا، فإننا نعيش في حالة من “الخداع الذاتي” (Bad Faith). كان سجن “بروكس” هو تعريفه الجاهز، وعندما انتُزع منه، انهار تحت وطأة حريته.
ألبير كامو وتمرد العبث
يقدم ألبير كامو، وهو شخصية رئيسية أخرى في الوجودية، منظورًا مختلفًا. في كتابه “أسطورة سيزيف”، يصف كامو الحالة الإنسانية بأنها “عبثية”. نحن، مثل سيزيف الذي حُكم عليه بدحرجة صخرة إلى قمة جبل إلى الأبد لتعود وتتدحرج مجددًا، نعيش حياة مليئة بالمهام المتكررة التي قد تبدو بلا معنى في كون صامت لا يبالي. يرى كامو أن السؤال الفلسفي الجوهري هو: هل الانتحار هو الحل العقلاني لمواجهة هذا العبث؟ إجابته هي “لا” قاطعة. الانتحار هو استسلام، أما الحل الحقيقي فهو التمرد. يجب أن ندرك عبثية الحياة ونحتضنها، أن نعيش بشغف وعصيان، وأن نجد حريتنا في مواجهة مصيرنا. يقول كامو جملته الشهيرة: “يجب أن نتخيل سيزيف سعيدًا”، لأنه في لحظة وعيه بمصيره وقبوله له، يصبح سيدًا على صخرته. هذا الموقف يجد أصداء في الفلسفة الرواقية القديمة، التي دعت إلى التركيز على ما يمكننا التحكم فيه (أفعالنا ومواقفنا) وقبول ما لا يمكننا التحكم فيه (العالم الخارجي).
فريدريك نيتشه وموت الإله
يأخذنا “الدحيح” إلى الوراء أكثر، إلى الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، الذي أعلن “موت الإله” في كتابه “العلم المرح”. لم يكن نيتشه يقصد موتًا حرفيًا، بل كان يشير إلى أن عصر التنوير والثورة العلمية قد قوّضا الأسس الدينية التي كانت تمنح العالم الغربي إطارًا أخلاقيًا ومعنىً للحياة. هذا “الموت” يخلق فراغًا هائلاً (عدمية)، حيث لا يعود هناك “صح” أو “خطأ” مطلق. لكن هذا الفراغ، في نظر نيتشه، هو أيضًا فرصة. إنه يدعو إلى ظهور “الإنسان الأعلى” (Übermensch)، الفرد القوي الذي يتجاوز الأخلاق التقليدية ويخلق قيمه الخاصة، ويفرض إرادته على الحياة ليمنحها معنى خاصًا به. إنها دعوة لتحمل المسؤولية الكاملة عن وجودنا في عالم بلا ضمانات.
سورين كيركجارد وقفزة الإيمان
في مقابل هذه الرؤى التي قد تبدو إلحادية، يقدم البرنامج وجهة نظر الوجودية المؤمنة من خلال الفيلسوف الدنماركي سورين كيركجارد، الذي يُعتبر “أبو الوجودية”. يرى كيركجارد أن الحياة البشرية تمر بثلاث مراحل: المرحلة الحسية (العيش من أجل المتعة والهرب من الملل)، والمرحلة الأخلاقية (الالتزام بالقوانين والواجبات المجتمعية)، وأخيرًا المرحلة الدينية. الانتقال إلى المرحلة الأخيرة يتطلب “قفزة إيمان” (Leap of Faith). هذه القفزة ليست قرارًا عقلانيًا مبنيًا على الأدلة، بل هي اختيار ذاتي وشخصي للإيمان في مواجهة الشك والعبث. المثال الأبرز عند كيركجارد هو قصة النبي إبراهيم، الذي كان على استعداد للتضحية بابنه طاعةً لأمر إلهي يتجاوز كل منطق بشري وأخلاقي. الإيمان، بالنسبة لكيركجارد، ليس فهمًا، بل هو علاقة شخصية وعاطفية مع الله، وهو الاختيار الذي يمنح الحياة معناها الأسمى في عالم غير مفهوم. هذا المفهوم يجد بعض التشابه في تقاليد أخرى، مثل مفهوم “بهاكتي يوغا” في الهندوسية، الذي يركز على التفاني العاطفي والمحبة كطريق للاتصال بالإلهي.
خلاصة وتطبيقات حديثة
ما يجمع هؤلاء الفلاسفة، رغم اختلافاتهم، هو إقرارهم بأن الوجود الإنساني صعب ومقلق، وأننا كائنات حرة مسؤولة عن إيجاد أو خلق المعنى في حياتنا. تتفق أفكارهم مع مدارس العلاج النفسي الحديثة. فيكتور فرانكل، الطبيب النفسي النمساوي الذي نجا من معسكرات الاعتقال النازية، أسس “العلاج بالمعنى” (Logotherapy)، مؤكدًا أن الدافع الأساسي للإنسان هو البحث عن معنى لحياته. كما حدد الطبيب النفسي الوجودي إيرفين يالوم أربعة “هموم أساسية” للوجود: الموت، والحرية، والعزلة، واللامعنى، معتبرًا أن مواجهة هذه الهموم هي جوهر العلاج النفسي.
في النهاية، لا تقدم الفلسفة الوجودية إجابات سهلة أو وصفات جاهزة. إنها، كما يوضح “الدحيح”، ليست مجموعة من العقائد، بل هي “أسلوب في التفلسف” يدعونا إلى التفكير بصدق في حالتنا. إنها تذكير بأننا، على عكس الكائنات الأخرى، لسنا مجرد مخلوقات بيولوجية، بل نحن مشاريع وجودية. كل واحد منا يختار كيف يرى العالم وكيف يتعامل معه. سواء اخترنا أن نخلق المعنى بأنفسنا على طريقة سارتر، أو نتمرد على العبث مع كامو، أو نقوم بقفزة إيمان مع كيركجارد، فإن القاسم المشترك هو أن الاختيار لنا، والمسؤولية تقع على عاتقنا.
تنويه: هذا المقال يلخص آراء الخبراء والدراسات المتاحة لأغراض تعليمية فقط، ولا يعتبر استشارة طبية.