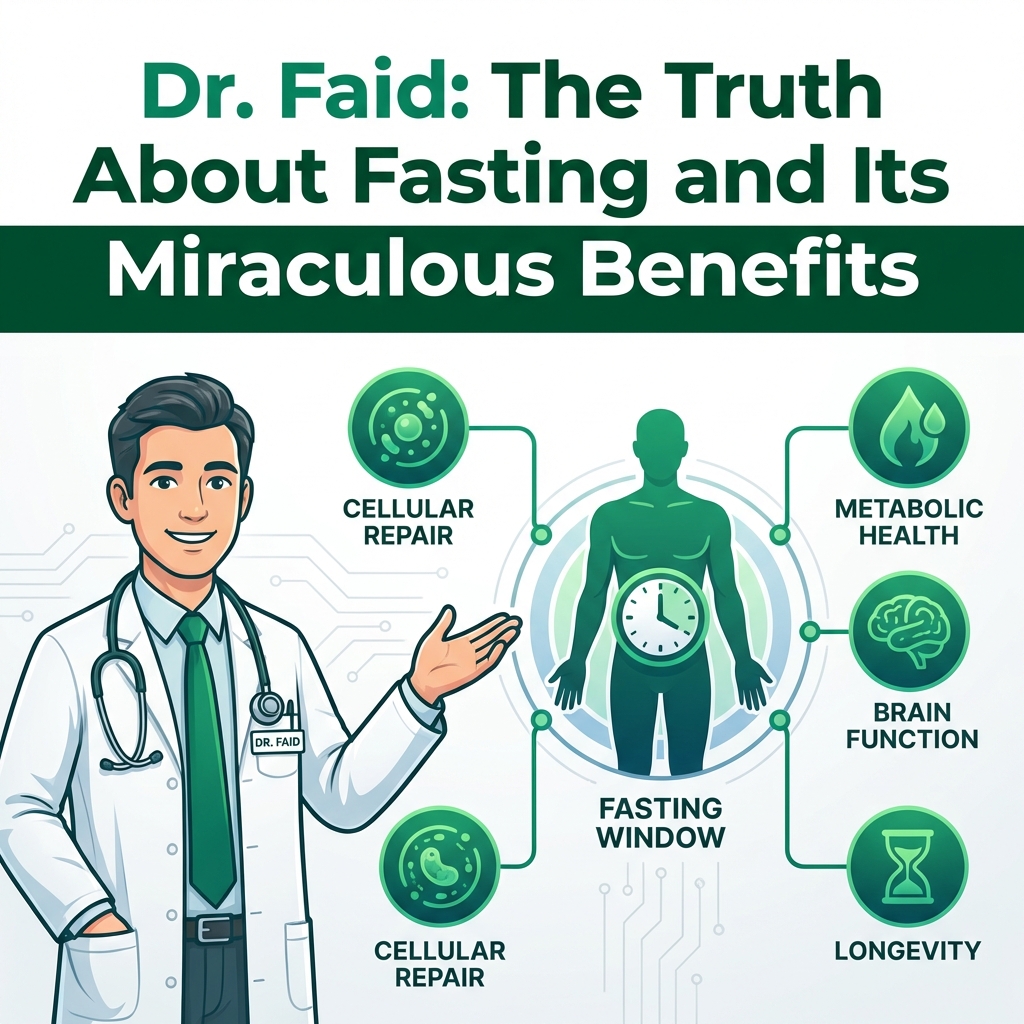ماذا لو كانت قصةٌ تأسيسية في التاريخ الإسلامي، طالما نُبذت واعتُبرت من الزندقة، تحمل في طياتها مفتاح فهم تناقض جوهري في صميم القرآن نفسه؟ في نقاش حديث عبر الإنترنت، غاص المفكر محمد صالح في الحكاية المثيرة للجدل المعروفة بـ “قصة الغرانيق” أو “الآيات الشيطانية”، كاشفًا كيف أن هذه الرواية، رغم رفضها الرسمي، قد تكون ضرورية لتفسير آيات قرآنية أخرى، مما يفتح الباب أمام سلسلة من الأسئلة المقلقة حول طبيعة النص ومصدره.
في حديثه، استعرض صالح الإشكالية التي تمثلها هذه القصة. تبدأ الحكاية، كما وردت في بعض كتب السيرة والتفسير مثل تفسير الطبري وتاريخه، بأن النبي محمد، أثناء تلاوته لسورة النجم أمام كفار قريش، ورغبة منه في استمالتهم، أضاف بعد آية “أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ” عبارة “تلك الغرانيق العُلى، وإن شفاعتهن لَتُرتَجى”، مادحًا بذلك آلهتهم. وتقول الرواية إن قريشًا فرحوا بذلك وسجدوا معه. لاحقًا، نُسب هذا الحدث إلى إلقاء الشيطان هذه الكلمات على لسان النبي.
يشير صالح إلى أن علماء الحديث، ومنهم ابن حجر العسقلاني في “فتح الباري”، ضعفوا هذه الرواية واعتبروها “مرسلة” (أي أن سندها منقطع ولا يصل إلى النبي)، وبالتالي لا تصح. لكن هنا تكمن المعضلة الكبرى التي طرحها النقاش: إذا كانت القصة باطلة ولم تحدث، فلماذا توجد آية في سورة الحج تبدو وكأنها نزلت لتبرير هذا الحدث على وجه التحديد؟ الآية هي: “وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” (الحج: 52).
هذا التوافق بين الرواية المرفوضة والآية القرآنية يخلق مفارقة حادة. فإما أن الرواية صحيحة والآية نزلت لتفسيرها، مما يضرب مفهوم “عصمة النبي” (حمايته من الخطأ في تبليغ الوحي)، وإما أن الرواية باطلة، مما يجعل وجود آية تبررها في القرآن أمرًا غريبًا وغير منطقي. يرى صالح أن هذا التناقض يقوض فكرة أن القرآن نص متماسك ومن مصدر إلهي واحد عليم وحكيم.
عند البحث الأكاديمي حول هذه القضية، نجد أنها كانت محور نقاش واسع. المستشرق والمؤرخ وليم موير في كتابه “حياة محمد” (The Life of Mahomet) اعتبر القصة حدثًا تاريخيًا حقيقيًا، ورأى أنها تعكس مرحلة من التردد والتسوية السياسية في دعوة النبي. في المقابل، يرفض معظم العلماء المسلمين المعاصرين القصة رفضًا قاطعًا، معتبرين إياها من اختلاق الزنادقة لتشويه صورة النبوة. ومع ذلك، فإن باحثين مثل المستشرق جون بورتون في كتابه “مجموعة القرآن” (The Collection of the Qur’an) يجادلون بأن وجود الآية 52 من سورة الحج يشير بقوة إلى أن الرواية كانت متداولة ومقبولة في فترة مبكرة من الإسلام لدرجة استدعت ردًا قرآنيًا عليها.
نمط من التناقضات الداخلية
لم يتوقف النقاش عند قصة الغرانيق، بل اعتبرها صالح مجرد مثال واحد ضمن نمط أوسع من التناقضات الداخلية في القرآن. وأشار إلى عدة أمثلة أخرى تثير إشكاليات منطقية ولاهوتية:
-
الإرادة الحرة والجبرية: كيف يمكن التوفيق بين آيات تمنح الإنسان حرية الاختيار المطلقة مثل “فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ” (الكهف: 29)، وآيات أخرى تسلب هذه الإرادة وتجعل الهداية حكرًا على الله مثل “إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ” (القصص: 56)، ثم آيات تجمع بين المشيئتين بطريقة غامضة مثل “وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ” (التكوير: 29)؟ هذا التضارب يجعل من الصعب بناء عقيدة واضحة حول مسؤولية الإنسان.
-
آيات السلم والحرب: أشار صالح إلى التناقض الصارخ بين آيات تدعو إلى السلم والعفو مثل “لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ” (الكافرون: 6)، وآيات أخرى تأمر بالقتال. واستشهد برأي الشيخ عبد العزيز بن باز الذي اعتبر “آية السيف” في سورة التوبة: “فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ…” (التوبة: 5) ناسخةً لكل آيات العفو والصفح التي سبقتها. فكرة “النسخ” (إلغاء حكم آية بآية أخرى) بحد ذاتها تثير تساؤلات حول الطبيعة الأزلية والمطلقة للوحي الإلهي. وقد تناول مفكرون مثل محمد شحرور هذه القضية، رافضين فكرة النسخ بالمطلق ومقدمين تفسيرات بديلة تحاول الحفاظ على تماسك النص.
-
آية الميثاق الكوني: تطرق النقاش إلى آية سورة الأعراف: “وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا…” (الأعراف: 172). تشرح الآية أن الله أخذ ميثاقًا من كل البشر قبل ولادتهم بأن يعترفوا به ربًا. الإشكالية التي طرحها صالح هي أن لا أحد من البشر يمتلك أي ذكرى لهذا الحدث الجلل. فكيف يمكن محاسبة إنسان بناءً على عهد لا يتذكره؟ هذا يجعل أساس المسؤولية الدينية مبنيًا على فرضية غيبية لا يمكن التحقق منها، وهو ما يتعارض مع مفاهيم العدالة المنطقية. هذا المفهوم له أصداء في الفلسفات القديمة، مثل نظرية “التذكّر” (Anamnesis) عند أفلاطون، التي تفترض أن المعرفة هي استرجاع لأفكار مثالية عرفتها الروح قبل ولادتها، لكنها تبقى في نطاق التأمل الفلسفي لا العقيدة الملزمة.
حجاب القداسة والعقل النقدي
أحد المحاور الرئيسية في الحوار كان حول الأثر النفسي لـ “القداسة” على العقل. يرى صالح أن تقديس النص يمنع القارئ من التعامل معه بشكل نقدي وموضوعي. عندما يُقرأ النص بوصفه كلامًا إلهيًا مقدسًا، يتم تعطيل العقل وتبرير أي تناقض أو لا منطقية فيه. وقد استشهد بمقولة للشيخ المصري محمد حسين يعقوب الذي شبه العقل بـ “الحمار” الذي يجب على المؤمن أن يتركه خارج “دوار العمدة” (أي الحضرة الإلهية أو المسجد) ويدخل بدونه.
هذه الفكرة لاقت صدى لدى أحد المتصلين الذي وصف تجربته قائلًا: “القداسة راحت، صرت أقرأ النصوص من غير قداسة، أقرأها بعقلي بس… هذا الكلام فارغ”. هذه الشهادة تلخص التحول الذي يحدث عندما يُرفع حجاب القداسة، حيث تبدأ التناقضات التي كانت تُبرر أو يتم تجاهلها بالظهور بشكل صارخ.
إشكالية تجسيد الإله (الأنسنة)
امتد النقاش إلى مستوى فلسفي أعمق عند الحوار مع متصل آخر. جادل صالح بأن أي محاولة لوصف الإله أو تحديد أفعاله (مثل أنه يرسل الأنبياء، يغضب، يضحك، يعاقب) هي في جوهرها عملية “أنسنة” (Anthropomorphism). فنحن نسقط مفاهيمنا وتصوراتنا البشرية المحدودة على كائن يُفترض أنه متعالٍ ومختلف كليًا عن مخلوقاته. العقل البشري، بكونه قاصرًا، لا يمكنه أن يدرك حقيقة الإله، وبالتالي فإن أي “منطق إلهي” ننسبه إليه هو في الحقيقة انعكاس لمنطقنا البشري.
وقد ظهرت هذه الإشكالية بوضوح عند طرح “مفارقة الصخرة” الكلاسيكية: “هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟”. هذا السؤال يضع قدرة الإله المطلقة في مواجهة مع نفسها، ويكشف حدود المنطق البشري في التعامل مع اللانهايات. عدم قدرة المتصل على تقديم إجابة حاسمة كان دليلاً، في نظر صالح، على أن المنظومة الدينية نفسها تقف عاجزة أمام هذه التحديات المنطقية.
الفراغ التاريخي والأنثروبولوجي
في نهاية النقاش، أثيرت نقطة بالغة الأهمية تتعلق بالدليل التاريخي. أشار أحد المتصلين إلى الغياب التام لأي دليل أثري أو تاريخي مستقل (خارج النصوص الدينية نفسها) يدعم وجود شخصيات محورية مثل إبراهيم أو موسى أو حتى محمد. لدينا سجلات مفصلة ومومياوات ونقوش لحضارات أقدم بكثير مثل الفراعنة والسومريين، لكن لا يوجد أثر مادي واحد يؤكد القصص الدينية عن الأنبياء.
هذا “الصمت التاريخي” يمثل تحديًا كبيرًا للمؤمنين. يتساءل النقاد: كيف يمكن لشخصيات بهذا الحجم، قادت أممًا وشقت بحارًا وأسست دولاً، ألا تترك أي أثر في سجلات الحضارات المعاصرة لها؟ يضاف إلى ذلك التساؤل الأنثروبولوجي: كيف يمكن إرسال نبي برسالة معقدة إلى مجتمعات بدائية لا تملك لغة متطورة أو نظام كتابة، مثل قبائل الأمازون أو سكان أستراليا الأصليين؟ إن فكرة “لكل قوم هاد” تبدو غير قابلة للتطبيق عمليًا في سياق التطور البشري.
في الختام، يخلص النقاش إلى أن التناقضات الداخلية، والاعتماد على أساطير غير قابلة للتحقق، والفراغ التاريخي، والإشكاليات الفلسفية العميقة، كلها تشير إلى أن النص القرآني، وغيره من النصوص الدينية، هو على الأرجح نتاج بشري مركب يعكس مراحل مختلفة من التطور الفكري والاجتماعي والسياسي، وليس وحيًا منزلاً من مصدر إلهي واحد، مطلق العلم والحكمة.
تنبيه: هذا المقال يلخص آراء الخبراء والدراسات المتاحة لأغراض تعليمية وتثقيفية فقط، ولا يمثل نصيحة طبية أو دينية.